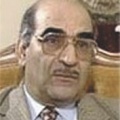السبب واسطة.. والعلة مؤثرة! والخلفية السياسية: المسؤولية
بعد أن عرضنا (في المقال السابق والذي قبله) لمسألة السببية وكيفية تأثير الأشياء بعضها في بعض - من وجهة نظر المتكلمين القدامى ـ قد يحسن بنا أن نلفت النظر إلى الاختلاف الواسع جدا بين ما كان يتناقش فيه المتكلمون القدامى وما يتناقش فيه "المتكلمون المعاصرون" الذين "يتكلمون" باسم الدين في أمور تخص الدنيا والآخرة ولا هي من الدين ولا من أصوله ومقاصده ولا منهاجه.
لنستمع إلى المتكلمين القدامى، فهم الذين فكروا وتكلموا في أشياء كثيرة بمحض عقولهم، وقد خلدت أسماءَهم كتُبهم وكتبُ من أرخ لهم. تكلموا مثلا في قضية السببية والعلية، وهي من قضايا العقل والدين معا، وفيما يلي الخبر:
العلة عند المتكلمين وصف في الشيء مؤثر فيه نوعا من التأثير، في حين أن السبب هو مجرد واسطة أو رابطة بين شيئين ولا تأثير له. وعلى الرغم من أنه جرى على ألسنة البيانيين من فقهاء ومتكلمين ونحاة استعمال "العلة" بمعنى السبب، والسبب بمعنى العلة، سواء في الاستعمال اللغوي (وهذا علة لهذا أي سبب، لسان العرب) أو في الاستعمال الاصطلاحي، فإن هذا لم يكن مقبولا في الحقل المعرفي البياني إلا عندما يُغض النظر عن التأثير. وفي هذه الحالة يستعمل لفظ علة في معنى السبب وليس العكس.
ولا بد من التأكيد هنا على مسألة أساسية، وهي أن العلة في التصور البياني ليست ذاتا، بل هي صفة للذات، أما السبب فهو ذات أي واسطة كالحبل مثلا. وفي المنظور الديني الإسلامي الذوات لا تؤثر بنفسها طبقا لمبدأ "لا فاعل في الحقيقة إلا الله". لذلك نجد الجويني مثلا يحرص على لفت الانتباه إلى أن العلل بما أنها مؤثرة، فهي ليست ذوات، بل معان فقط، يقول: "ومما ينبغي أن يحيطوا به علما أن يعلموا أن العلل يستحيل أن تكون ذواتا قائمة بنفسها، بل يجب القطع بكونها معاني"، وهذا ليس فقط لأن الذات لو عللت لكانت العلة ذاتا أيضا ويتسلسل إلى قدم العالم، بل أيضا لأن نظرية الجوهر الفرد المؤسسة للرؤية البيانية لا تقبل أن تكون العلل ذواتا قائمة بنفسها وفي غيرها. إن هذه النظرية تنص، كما شرحنا ذلك قبل، على أنْ ليس ثمة في الوجود إلا الجواهر والأعراض، وبما أن الجواهر متجانسة متماثلة فلا مجال لتصور كون بعضها يؤثر في بعض. وإذن فالتأثير، إذا وجد، فسيكون على مستوى الأعراض لا على مستوى الجواهر، والأعراض كما نعرف صفات ومعان وليست ذواتا.
في هذا الإطار يجب أن نضع فكرة التولد عند المعتزلة، فالتولد لا يعني السببية، بل يعني فقط حدوث الفعل بوسائط. وعندما يستعمل المعتزلة كلمة "سبب" في تحليلهم للتولد فهم يقصدون بها الواسطة ليس إلا، أي المعنى اللغوي نفسه للكلمة، وبالتالي فهم لا ينسبون التأثير لهذه الوسائط، لأن التأثير عندهم لا يصدر إلا عن قادر، والقادر عندهم إما قادر بقدرة قديمة وهو الله، وإما قادر بقدرة محدثة، أحدثها فيه الله، وهو الإنسان. يقول القاضي عبد الجبار أحد شيوخ المعتزلة: "إن القول في إيجابِ السبب للمسبَّب بخلاف القول في إيجاب العلة للمعلول. لأن ما توجبه العلة لا ينفصل عنها.. وما يوجبه السبب منفصل عنه لأنه حادث آخر، فغير ممتنع أن يوجد (السبب) والمسبَّب معدوم، وإن كان لا بد من وجوده قبله ليجب (وجوده) بعده".
وإذن فالعلاقة بين السبب والمسبَّب (= المتولد) ليست علاقة ضرورية، لأنها ليست علاقة تأثير، إنما هي علاقة وصل، لذلك يجوز عندهم أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب، كأن يوجد الحبل ولا يوجد الماء في الدلو، كما يجوز عندهم أن يقترن حدوث المسبَّب مع وجود السبب ويمكن أن يتأخر عنه بأن يكون هناك فاصل بينهما. ولا يمكن بطبيعة الحال أن يكون هناك فعل مسبَّب دون سبب، لأن هذا يعني وجود فعل متولد دون واسطة.
من هنا ارتباط التولد بالاعتماد عند المعتزلة وقد ذهب بعضهم إلى القول إن المولِّد هو الاعتماد فقط وإن "كل ما تعدى محل القدرة (قدرة الذي صدر منه الفعل) فالاعتماد يولده فقط"، بمعنى أنك إذا ضربت شخصا فما يجب أن ينسب إليك هو فعل الضرب فقط، لأن الله أقدرك عليه عندما أردته. أما الألم الذي يحس به المضروب فلست أنت الذي فعلته أو ولَّدته، بل ولّده "الاعتماد" (أي الضغط أو الثقل النازل على المحل المضروب من الجسم). ومثل ذلك الشخص إذا رمى حجرا فلقي هذا الحجر في طريقه حجرا آخر فتدحرج به هذا الأخير فأصاب شخصا فجرحه، فالجرح هنا سببه "الاعتماد" الذي في الحجر الثاني الذي ولده فيه اصطدامه مع الحجر الأول، (السبب هنا ميكانيكي وليس إراديا).
ذلك هو رأي المعتزلة في "التولد" وعلاقة الأسباب بالمسببات، وقد تبناه الأشاعرة ولم يخالفوهم إلا في نقطة واحدة هي: هل المتولدات عن فعل الإنسان يجب أن تنسب إلى قدرة الله مباشرة مثل الفعل الإنساني نفسه، وهذا رأي الأشاعرة، أم أنها يجوز أن تنسب إلى القدرة التي أحدثها الله في الإنسان التي إليها ترجع أفعاله، وهذا رأي معظم المعتزلة. والخلاف في هذه المسألة امتداد مباشر لمسألة "الأفعال": أفعال الإنسان وما يترتب عنها من مسؤولية، وبالتالي من جزاء. وكما هو معروف فالمعتزلة يقولون: "إن أفعال العباد، من تصرفهم وقيامهم وقعودهم، حادثة من جهتهم وإن الله جل وعز أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم"، وهذا هو معنى قولهم: "الإنسان يخلق أفعاله". وهم يسمون هذا النوع من الفعل البشري فعلا "مخلوقا" للإنسان بمعنى أنه أتاه بقدرة أحدثها فيه الله، وإنما سموه كذلك "فصلا بينه وبين الفعل الواقع على جهة السهو والتبخيت". أما تصرف الساهي والنائم فهو "كتصرف العالم في أنه حادث من جهته.. يدل على ذلك أنه يقع منه على الحد الذي يقع منه في حال يقظته".
والقاعدة عندهم في تمييز الأفعال المخلوقة للإنسان بهذا المعنى والأفعال التي يجب أن تنسب إلى الله مباشرة: أن تَنظر في الفاعل و"تَختبر حاله، فإن وجدْتَ الفعل يقع بحسب قصده ودواعيه وينتفي بحسب كراهته وصارفه حكمت بأنه فعل مخصوص"، أي مخلوق له. أما إن وجدت أن الفعل "لا يجوز أن يكون مقدورا للقادر بالقدرة (= التي للإنسان) فيجب أن يكون مقدورا للقادر بذاته وهو الله تعالى".
وهكذا فالسكون والحركات على اختلاف أجناسها والاعتمادات على اختلافها والمتولدات كالتأليف والألم والصوت والكلام وكذلك النظر والندم والاعتقادات المبتدَأة (التي ليست نتيجة استدلال) والظن، كل ذلك يقع بقصد الإنسان ودواعيه وهي مقدورة له بالقدرة التي يحدثها الله فيه، وبالتالي فهي أفعال له. أما الروائح والطعوم والألوان والحرارة والبرودة.. فهي غير مقدورة للإنسان بمعنى أن الله لم يمنحه القدرة على إحداثها، وبالتالي فلا يستطيع فعلها إنما هي من خلق الله مباشرة. والمر هنا يتعلق أصلا بالمسؤولية: الإنسان مسؤول عن جميع الأفعال التي يقدر عليها، أي الأفعال الإرادية، وهو غير مسؤول عن لا دخل لإرادته فيها. والخلفية السياسة لهذه الفكرة سبق أن ناقشناها وهي إثبات مسؤولية الحكام والفاعلين من البشر جميعا، وبالتالي إثبات استحقاقهم للجزاء: ثوابا أو عقابا.
هذا عند المعتزلة أما الأشاعرة فلهم رأي آخر أساسه القول بـ "الكسب"، وهو مفهوم غامض حتى ضرب بغموضه المثل فقيل في الشيء الغامض: "أخفى من كسب الأشاعرة" كما سنرى في المقال المقبل. وقبل ذلك ينبغي أن نشير إلى أن معظم الفقهاء يستعملون لفظ "العلة" بدل "السبب"، والتأثير الذي يقولون به هو كونها توجب حكما في الشرع وهو التحريم. "الإسكار" (بمعنى غياب العقل وبالتالي عدم المسؤولية) ينتج عن شرب الخمر مثلا، فهو العلة أو الوصف الذي في الخمر والذي أوجب تحريمه.