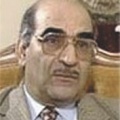الطفرة والاعتمادات
لما كان إبراهيم بن سيار النظام المتكلم المعتزلي المشهور، تلميذ أبي الهذيل العلاف، قد عارض القول بالجوهر الفرد، وقال إن الجزء يتجزأ إلى ما لا نهاية له من الأجزاء، ولما طرحت عليه مشكلة سرعة الرحى الذي ذكرناه في المقال السابق قال: إن الاختلاف بين سرعة الرحى في محيطها وبين سرعتها في مركزها راجع إلى "الطفرة"، فقال: إنه يجوز أن ينتقل الجزء، أو يطفر، من المكان الأول إلى المكان الرابع مثلا دون أن يمر بالثاني والثالث، الشيء الذي يعني أن محيط الرحى "يماس أشياء لم يكن حاذى ما قبلها".
غير أن نظرية النظام يرفضها القائلون بالجوهر الفرد، وهم الأغلبية الساحقة من المتكلمين معتزلة وأشاعرة، لا لأنهم يعارضون القول بـ "الطفرة"، فالحركة عندهم أجزاء لا تتجزأ، وبالتالي فهي تتم طفرة أي بانفصال، بل لأنهم يقولون إنه "لا بد أن يحاذي القاطع أجزاء المقطوع، ولا يجوز أن يحاذي البعض، ولا يحاذي البعض الآخر.. فالطفرة ليست بأكثر من قطع المقطوع المطفور، ولا يمكن قطعه إلا بأن يحاذي جميع أجزائه".
وإلى جانب هذا النوع من الحركة، الذي هو حركة نقلة وطفرة، هناك نوع آخر سماه النظام بـ "حركة الاعتماد"، وقد أخذ به أيضا القائلون بالجوهر الفرد. و"الاعتماد" عندهم هو عبارة عن نزوع دائم في الجسم الساكن نحو الحركة، فكأن "الأصل" في الأشياء أن تتحرك. وإذا كانت حركة النقلة هي انتقال الجسم من موضع إلى موضع، فإن حركة الاعتماد هي حركته في موضعه نفسه، وهذا ما عناه النظام بقوله: "لا أدري ما السكون إلا أن يكون يعني كان الشيء في المكان وقتين، أي تحرك فيه وقتين".
والواقع أن مفهوم الاعتماد من المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها الرؤية البيانية "العالمة" للعالم، كما صاغها المتكلمون. فلقد فسروا به ظواهر طبيعية عديدة مختلفة، ولكن مترابطة، لم يكونوا قد تبينوا بوضوح الفرق بينها. فمفهوم الاعتماد عندهم يشمل ما نعبر نحن اليوم عنه، في علم الفيزياء، بعدة مفاهيم مثل: المقاومة، الجاذبية، القوة، العطالة. فالظاهرة الطبيعية التي تنشأ من تفاعل الجاذبية والعطالة والمقاومة يفسرونها بـ "الاعتماد".
ولكي يتغلبوا على الغموض الذي يكتنف هذا المفهوم ميزوا بين نوعين من الاعتمادات: "الاعتمادات المجتلبة" (=أو العلوية) و"الاعتمادات اللازمة" (=أو السفلية). فالجسم الذي نلقي به في الهواء إلى فوق يصعد بفعل اعتماداته المجتلبة (التي تعني هنا القوة، قوة الدفع) ولكنه لا يلبث أن ينعكس ويهبط ليسقط إلى أسفل بفعل اعتماداته السفلية التي تعني هنا الثقل (جاذبية الأرض). وإذن فظاهرة سقوط الأجسام ترجع إلى تغلب الاعتمادات السفلية على الاعتمادات العلوية بسبب مدافعة الهواء (ضعف المقاومة).
أما إذا تساوت الاعتمادات السفلية مع الاعتمادات العلوية فإن الجسم الملقى به في الهواء يبقى لابثا هناك لا يسقط، مثله في ذلك مثل الحبل الذي يتجاذبه شخصان من طرفيه، حيث تجتمع فيه اعتمادات مجتلبة من الجهتين، فإذا تكافأت لبث الحبل مكانه وسكن. غير أن السكون هنا لا يعني انعدام الحركة، ففي الحبل حركة كامنة هي الحركة التي يحدثها فيه الرجلان اللذان يجذبانه بقوتين متساويتين. وإنما ظهر سكون الحبل لتكافؤ قوتيهما. فالسكون إذن هو عبارة عن تكافؤ حركتين متضادتين في الجسم الواحد. وبتعبير معاصر: هو تكافؤ قوتين تعملان في جسم واحد، قوة دافعة وقوة مانعة. وهذا التكافؤ، تكافؤ القوى الدافعة والمانعة، هو معنى الاعتماد عندهم. وذلك أيضا هو معنى قولهم: السكون حركة اعتماد، وقولهم: "لا يجوز أن تتولد الحركة إلا عن الاعتماد، وكذلك السكون لا يتولد إلا عن الاعتماد". ومن هنا عرف بعضهم المكان بأنه: "ما اعتمد عليه الجسم الثقيل على وجه يَقِله ويمنع اعتماده من توليد الهُويّ".
الاجتماع والافتراق والحركة والسكون حالات، أو "أكوان"، تعتري الجواهر الفردة، وبالتالي الأجسام. وبما أنها تعرض للجواهر والأجسام وتزول، فهي أعراض مثلها مثل الصفات الأخرى التي تعرض للأجسام من شكل ولون وطعم ورائحة... إلخ. وإذن فالأجسام في نهاية التحليل جواهر وأعراض ليس غير. ومن هنا أحد المبادئ الأساسية عندهم، المبدأ الذي يعبرون عنه بقولهم : "ليس ثمة في الوجود غير الجواهر والأعراض"، وهو يشكل مع مبدأين آخرين سنذكرهما بعد: المبادئ الثلاثة التي تقوم عليها نظرية الجوهر الفرد التي تؤسس، كما قلنا، الرؤية البيانية "العالمة" للعالم بما فيه الإنسان.
ليس ثمة في الوجود غير الجواهر والأعراض. ليكن. لقد تعرفنا على الجواهر فلنتعرف على الأعراض قبل الخوض فيما يترتب عن هذا المبدأ من تصورات.
العَرض في الحقل المعرفي البياني يفيد معنى الطارئ على الشيء. وفي اصطلاح المتكلمين: "فالعرض: كل طارئ زائل"، أي كل ما لا يقوم بنفسه. يقول القاضي عبد الجبار. "أعلم أن العرض في أصل اللغة هو ما يعرض في الوجود ولا يطول البتة، سواء كان جسما أو عرضا، ولهذا يقال للسحاب عارض. أما في الاصطلاح فهو ما يعرض في الوجود، ولا يجب لبثه كلبث الجواهر والأجسام". ثم يضيف: "وقولنا: ولا يجب لبثه كلبث الجواهر والأجسام احتراز من الأعراض الباقية فإنها تبقى، ولكن لا على حد بقاء الأجسام والجواهر، لأنها تنتفي بأضدادها، والجواهر والأجسام باقية ثابتة". وإذا كان المعتزلة يميزون في الأعراض بين ما يبقى ما دام لم يحل محله ضده، كالحياة تبقى ما دام لم يحل محلها الموت، وكلاهما عرض عندهم، فإن الأشاعرة يقولون إن الأعراض كلها لا تبقى زمانين، أي لا تدوم بل تزول وتتجدد مع آنات الزمان الذي يقوم عندهم جميعا، معتزلة وأشاعرة، على الانفصال، أي يعتبرونه جواهر فردة كما سنبين بعد حين . من أجل ذلك نجد الأشاعرة يقولون في تعريف الأعراض : "والأعراض هي التي لا يصح بقاؤها، وهي التي تعرض في الجواهر والأجسام وتبطل في ثاني حال وجودها"، أي في اللحظة التي تلي لحظة وجودها ثم تزول ويستأنف وجودها، وهكذا. ومعنى ذلك أن الأعراض أجزاء لا تتجزأ مثلها مثل الجواهر، والفرق بينهما أن الجوهر يقوم بنفسه بينما الأعراض لا تقوم بنفسها، بل تقوم بالجواهر. فليس هناك بياض قائم بنفسه ولا حركة قائمة بنفسها ولا زمان قائم بنفسه ولا علم قائم بنفسه ولا حياة قائمة بنفسها... إلخ.. بل كل هذه معان تقوم بغيرها، أي بالجواهر والأجسام. وكما لا يقوم العرض بنفسه لا يقوم العرض بالعرض، فلا يقوم السواد بالحركة ولا يحمل البياض الحلاوة أو البرودة … لأن الحامل يجب أن يكون ثابتا، والعرض عندهم غير ثابت ولا مستقر بل هو في تجدد مستمر، ومن هنا المبدأ الثاني الذي يؤسس نظرية الجوهر الفرد والذي يعبرون عنه بقولهم : "العرض لا يبقى زمانين".