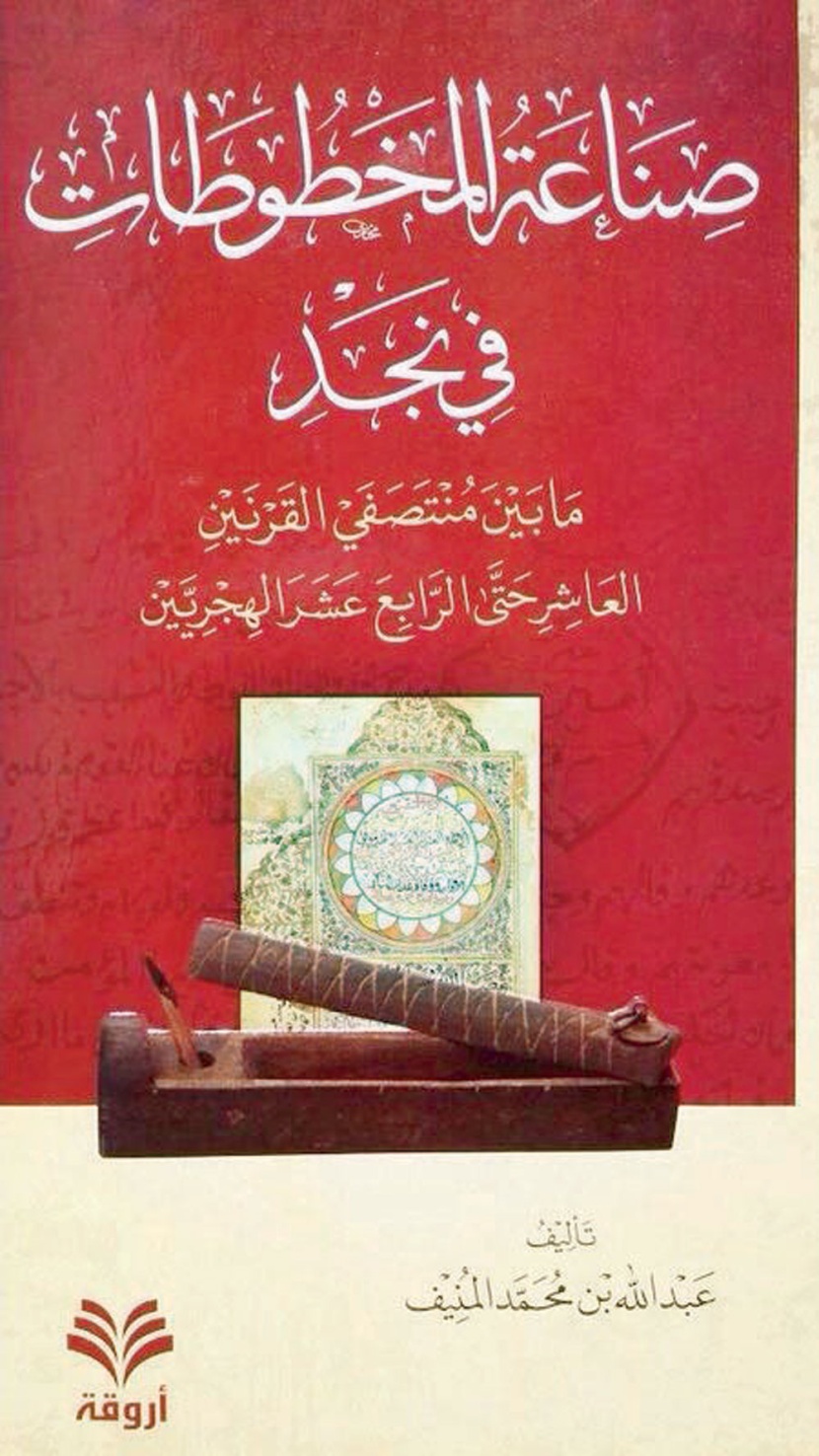صناعة المخطوطات
تفتقر المكتبة العربية إلى الدراسات في مجال صناعة المخطوطات، ويتهيب الباحثون الكتابة في هذا المجال، لأنه عمل مضن وشاق، يحتاج إلى وقت طويل، وجهد كبير. وهذا ما قام به الباحث المبدع الدكتور عبدالله بن محمد المنيف في كتاب الرائع والماتع والمفيد "صناعة المخطوطات في نجد"، الذي يعد عملا فريدا في مجاله. وقد تناولت أغلبية الأمم طرق صناعة المخطوطات الخاصة بها وإعدادها وتجهيزها، بغض النظر عن نوع المادة وطريقة الكتابة ورسم الحروف. كما نالت المخطوطات الإسلامية وصناعتها، وتطور كتابتها نصيبا من عناية الدارسين، وعلى العكس من ذلك لم تلق دراسة المخطوطات النجدية العناية نفسها التي لقيتها مخطوطات فارس أو العراق أو الشام أو مصر، أو المخطوطات التي خطت في الدولة العثمانية بصفتها آخر خلافة إسلامية. وكثير من الدارسين في العصر الحديث يجهلون طرق إعداد هذه المخطوطات وتجهيزها، وهنا تأتي أهمية الكتاب الذي بين أيدينا، خاصة إذا علمنا أن المخطوطات النجدية موجودة في نجد، وفي أماكن متعددة داخل السعودية، أو في مكتبات قريبة في دول مجاورة، انتقلت إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري؛ نتيجة للظروف المادية السيئة التي كانت غالبة على كثير من العلماء وطلبة العلم الذين كانت تغريهم وسائل العيش من مال وكسوة عن هذه المخطوطات، حين زهدوا فيها وأرسلوها هدايا أو مقابل الحصـول علـى مـا يسد حاجتهم. وكذلك الحروب التي شهدتها المنطقة في فترات مختلفة، إضافة إلى رحيل كثير من كتب نجد المحفوظة في مكتبات المدينة المنورة المختلفة عند قيام الحرب العالمية الأولى، حين عهد إلى أمين حسن الحلواني بالقيام بنقل مخطوطات المدينة إلى إسطنبول خشية عليها من الضياع أو التلف؛ إلا أنه يمم بها إلى أوروبا وباعها هناك.
ومنطقة نجد شبه مغيبة عن المصادر التاريخية والثقافية في القرون التي سبقت قيام الدولة السعودية الأولى، إذ أصبحت بعد ذلك محط أنظار العالم المحيط بها، سواء على المستوى السياسي أو على مستوى طلب العلم؛ فقد أعادت هذه الدولة لمنطقة نجد رونقها وجعلت طلبة العلم يفدون إلى عاصمتها الدرعية ثم الرياض من داخل نجد وخارجها وبهذا كثرت بعد قيام الدولة السعودية ووجود الحكومة المركزية القوية (صناعة المخطوطات) فأصبحت هناك مخطوطات نجدية واضحة المعالم. يتناول الكتاب إقليم نجد في الجزيرة العربية خلال المدة الزمنية من القرن العاشر حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري، بهدف إبراز دور علمائها في حركة التأليف، والتعرف إلى صناعة المخطوطات النجدية، وأدواتها العملية من خط ونسخ، وزخرفة وتجليد، وإظهار خصائصها الفنية، ومقارنة المخطوطات النجدية بمثيلاتها في الأقاليم المجاورة. كما تناول الكتاب الحركة العلمية في نجد، مثل الرحلات، والتعليم، والتأليف، والنسخ. وكذلك طرق تداول المخطوطات النجدية، مثل النسخ والاستكتاب، والشراء والبيع والإهداء والإرث. وكذلك المواد المستخدمة في صناعتها من ورق وأحبار وأقلام ومواد تجليد. كذلك تناول الكتاب العاملين بصناعة المخطوطات النجدية وتقسيمهم إلى نساخ وعلماء وقضاة ومحترفين وطلبة علم ومزوقين ومجلدين، إضافة إلى تحليل محتويات المخطوطات النجدية، مثل الشكل والعنوان والعناوين والديباجة والعناوين الفرعية والهوامش والمسطرة والخاتمة والترقيم، وكذلك الخطوط والزخارف.
والكتاب دراسة دقيقة ومحددة وقسم المؤلف الكتاب إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة مع المصادر والمراجع واللوحات والأشكال. وقد وفق المؤلف في تقسيم الفصول والمباحث الخاصة بكل فصل من ناحية التقسيم العلمي، والتوازن، والتدرج في عرض المعلومة وتحليلها بطريقة علمية وسهلة للقارئ تنم عن فهم وإتقان لموضوع الكتاب.
حيث تمهد المقدمة بصورة واضحة لموضوعات الكتاب وكيفية تناولها وأهدافه وأهميته. وجاء الفصل الأول، تحت عنوان: الدراسة التمهيدية، وقسمه إلى ثلاثة مباحث: الأول منها بعنوان: التطورات الاجتماعية والسياسية في إقليم نجد.
والمبحث الثاني بعنوان: الحركة العلمية في نجد خلال فترة الدراسة؛ تناول فيه دور رحلات الحج في الحركة العلمية وتنقل العلماء داخل نجد، ثم الرحلة خارج نجد، وأخيرا طرق التعليم وأماكنه. أما المبحث الثالث والأخير من هذا الفصل، فكان بعنوان: وظائف المخطوطات النجدية وأنواعها وطرق تداولها، وفيه عرج المؤلف على الوظائف التي يؤديها المخطوط النجدي وأنواع المخطوطات ودورها في الحياة النجدية، ومشاركة النجديين في التأليف في العلوم كعلوم الدين والتاريخ وعلم الرجال والتراجم والفلك والطب والحساب واللغة، وغيرها من العلوم. وأشهر طرق التداول للمخطوطات في نجد، وهي: النسخ والاستكتاب والشراء والبيع والإهداء والإرث.