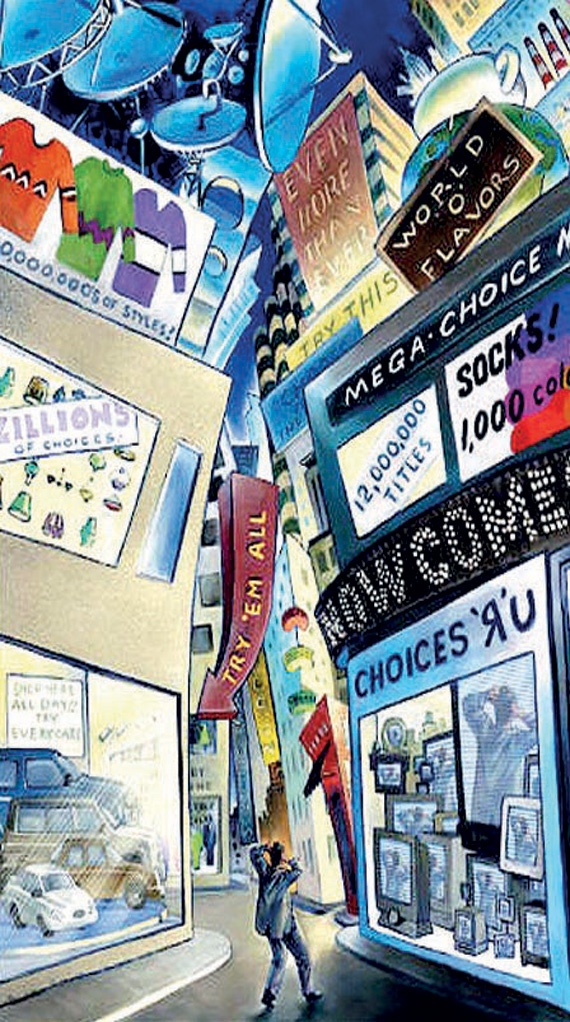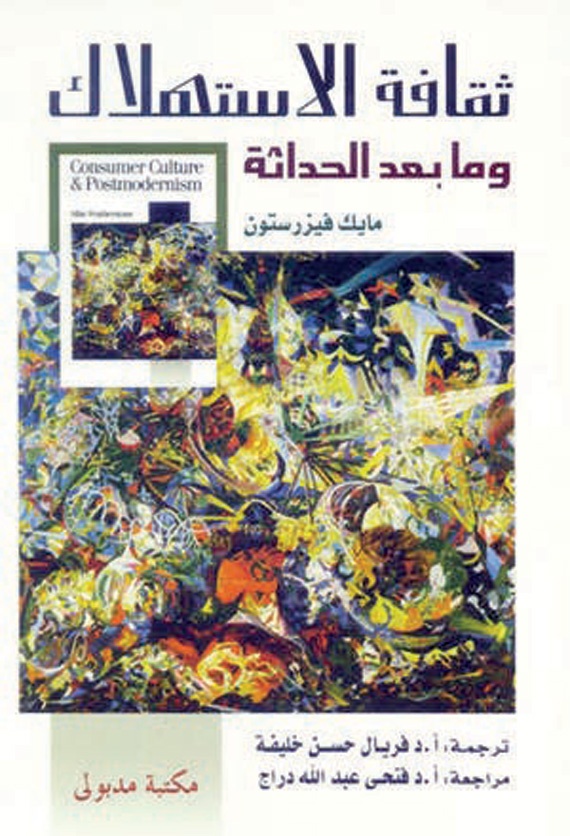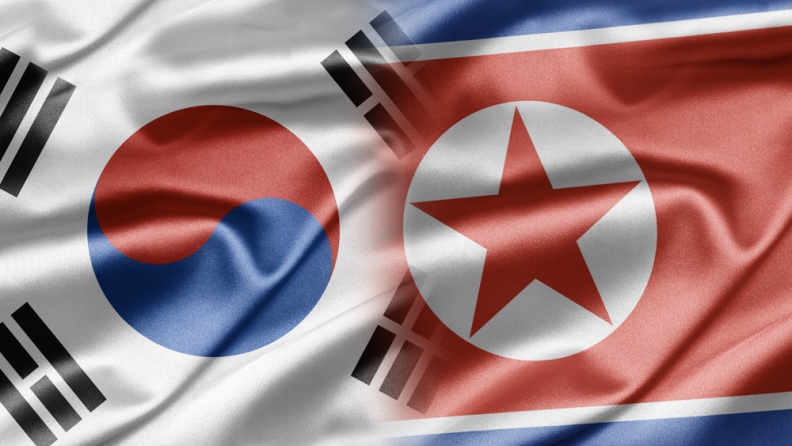ما بعد الحداثة .. المنطق الثقافي للرأسمالية المتأخرة
ما بعد الحداثة .. المنطق الثقافي للرأسمالية المتأخرة
في تقديمه لكتاب "ثقافة الاستهلاك وما بعد الحداثة" يعرض الباحث والمترجم فتحي دراج تحليلا لمنهج الكتاب وبنيته أو تحديدا لإشكالياته، ولكن بمنزلة فكرة موجزة تُبين كيف أصبحت ما بعد الحداثة القضية المحورية في الحياة الثقافية اليوم، خاصة أن هذا الكتاب يؤكد مكانة ما بعد الحداثة داخل العمليات التي تشكل المجال الثقافي، وتساعد على نهضة الثقافات الشعبية والكرنفالات، وتقوى الدوافع الشعبية للديمقراطية والمساواة والاعتراف بالآخر المختلف.
وليس هذا الكتاب مجرد بحث في العلاقة بين ثقافة الاستهلاك وما بعد الحداثة، ولكن تتشابك في تحليلاته النقدية كثير من القضايا البينية، وأعني بالبينية هنا فاعلية التأثير والتأثر بكثير من القضايا الأخرى ذات الصلة بثقافة الاستهلاك وما بعد الحداثة؛ مثل قضية الثقافة الشعبية والتحول إلى ما بعد الحداثة، والثقافة الرفيعة والتحديات التي تواجهها في عصر ما بعد الحداثة، والثقافة المشتركة والسؤال عن إمكانية بنائها على أساس وحدة التنوع الثقافي وشرعية الاختلاف، والثقافة الكوكبية، والعلاقة بين الثقافة والاقتصاد والتكنولوجيا والسياسية، والعلاقة بين رأس المال الثقافي ورأس المال الاقتصادي والتطور الحضري للمدن.
كما يتناول الكتاب أيضا ظهور ما يسمي بطبقة البرجوازية الصغيرة الجديدة وفئاتها المتنوعة من (المفكرين الجدد والوسطاء الثقافيين والفنانين والمديرين) ويكشف أيضا تناقضاتها الأساسية مع الطبقة البرجوازية الصغيرة القديمة أو التقليدية.
ووجه التباين بين ما يسمي بالمفكرين العالمين والمفكرين الجدد. فضلا عن تقدم علم اجتماع الثقافة وكيف أصبح موضع الاهتمام البحثي في قلب الحقل الاجتماعي، ومن القضايا المهمة أيضا التي يثيرها الكتاب العلاقة بين ثقافة الاستهلاك والمقدس.
ويبدأ الكتاب بتحديد مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة، ويشير إلى آراء النقاد حول مفهوم ما بعد الحداثة واعتبارها عند بعضهم نوعا من البدع أو الهوس الفكري، أو أنها مؤشر على التوعك في قلب الثقافة المعاصرة، أو أنها انعكاس لرد الفعل السياسي في العالم الغربي، أو أنها ثقافة منشقة، أو ثقافة روث، حلت محل الحداثة عن طريق وفرة الصور والرموز والتصنع والمعاني غير المترابطة والهلوسة الأستاطيقية، أو أنها رد فعل وتفكير آلي في التغيرات الاجتماعية.
ويشير فيزرستون إلى أنه لا يوجد اتفاق على معنى مصطلح ما بعد الحديث ومشتقاته. وغالبا تستخدم هذه المصطلحات بشكل فيه خلط و بطريقة قابلة لتبديل مصطلح بآخر.
ويحلل فيزرستون العلاقة بين الحديث وما بعد الحديث أو بين الحداثة وما بعد الحداثة، ويثير التساؤلات حول طبيعة هذه العلاقة وهل هي علاقة تواصل أم علاقة انقطاع؟
ويعتبر فيزرستون أن البادئة "ما بعد post " تشير إلى القطيعة والتناقض مع الحديث، لكن الحركة المتصلة في الابتعاد عن الحديث تجعل ما بعد الحداثة مصطلحا نسبيا غير محدد لكنه يشير إلى كل اجتماعي جديد يغاير تماما فترة الحديث، ويناقضها كما عبرت عن ذلك كتابات بورديارد وليوتار وجيمسون.
يرى بودريارد أن "تكنولوجيا المعلومات" هي محور التغير من النظام الاجتماعي الإنتاجي إلى النظام الاجتماعي الذي يشكل فيه فيضان الصور والرموز عالم التصنع، عالم ما بعد الحداثة، هلوسة أستاطيقية بلا عمق.
وكذلك يهتم ليوتار بتأثير التكنولوجيا على المعرفة، ويرى أن افتقاد المعني في ثقافة ما بعد الحديث لا يجب أن يكون مفجعا لأنه يشير إلى استبدال معرفة الرواية بتعدد الألعاب اللغوية، واستبدال العالمية بالمحلية.
بينما يعتبر جيمسون أن ما بعد الحداثة هي المنطق الثقافي للرأسمالية المتأخرة؛ الرأسمالية الاستهلاكية المتأخرة التي تبدأ بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو يعتبر الثقافة أساس المجتمع الاستهلاكي باعتباره مجتمعاً مشبعاً بالصور والرموز، وكل شيء فيه أصبح ثقافيا.
ويحدد جيمسون صفتين أساسيتين لما بعد الحداثة؛ الأولى: تحول الواقع إلى صور.
والثانية: تجزؤ الوقت في سلسلة لحظات حاضر مستمر أو عرض دائم، والمثال الذي يجسد كل من الصفتين هو الإعلام، ويرى جيمسون مثل بودريارد ثقافة الصورة خليطا من التصنع والتنوع النمطي وعدم التجانس الذي يؤدى إلى فقد الدلالة وموت الموضوع ونهاية الفردية.
#2#
أما عن الصفة الثانية أو الإدراك المجزأ للعالم عند المشاهد فإنه يعتبر سببا للشيزوفرينيا التي هي عامل من عوامل ما بعد الحداثة وتعتبر الشيزوفرينيا تحطيم للعلاقة بين المعاني، تحطيم للوقت والذاكرة ومعني التاريخ. فالخبرة الشيزوفرينية هي خبرة الانفصال والتفكك وعدم التواصل وهي المسؤولة عن تحول الواقع إلى صور.
وعند الطبقة الوسطي الجديدة الحياة الجمالية حياة طيبة أخلاقية، وأنه لا توجد طبيعة إنسانية أو ذات حقة، وكل الذوات متشابهة والحياة متاحة بشكل جمالي، ورغبة التعلم وإثراء الذات وإتباع القيم الجديدة والمفردات الجديدة.
هكذا يؤكد فيزر ستون أن هناك معضلات كثيرة تتشابك في فهم ما بعد الحداثة كعملية طويلة المدى تزيد من القوة الممكنة للمتخصصين في الإنتاج الرمزي والنشر وبالتالي تكون الحاجة مُلحة إلى العمل نحو علم اجتماع ما بعد الحداثة.
ويناقش فيزرستون قضية التغير الثقافي والممارسة الاجتماعية، ويري أن القاعدة الثقافية العميقة للتحديث أوجدت العلم والمعرفة والمذهب الإنساني والماركسية والنسائية ... إلخ، وهي مذاهب تطمح إلى تقديم طرق مرشدة جازمة للبشرية من أجل كل من معرفة العالم وفعل الممارسة فيه، وعلى النقيض أثارت ما بعد الحداثة أسئلة بعيدة المدى حول طبيعة التغير الثقافي والعلاقات "الميتانظرية أو ما بعد النظرية" التي تبحث ما بعد الحداثة عن تحليل لها.
ويكتب ليوتار عن نهاية الروايات أو نهاية السرد لتفسير ظهور ما بعد الحديث، ويفهم جيمسون ما بعد الحداثة بوصفها المنطق الثقافي للرأسمالية الاستهلاكية المتأخرة أو الفترة الثالثة، فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وكان من أهم التغيرات باسم الديمقراطية إزالة التمييز بين الثقافة الشعبية والثقافة الرفيعة، ولم يكترس المفكرون المؤيدون لذلك بأن تدمير الثقافة الرفيعة فيه تهديد للنظام المستقر. بل إنهم إلى جانب ذلك يعلنون فضائل الثقافة الشعبية والجماهيرية وثقافة ما بعد الحديث.
وبالتالي لفهم ما بعد الحداثة يجب أن نفهم التغيرات في المجالات الأكاديمية والفكرية والفنية، وذلك ظاهر في الصراعات التنافسية، والتغيرات في المجال الثقافي الأوسع وأساليب الإنتاج والتداول والنشر للسلع الرمزية، والتغيرات في توازنات القوى والاعتمادات المتبادلة بين الجماعات والفئات الطبقية، والتغير في الممارسات اليومية وخبرات الجماعات المختلفة، واستخدام نظم المعنى والوسائل الجديدة في التوجيه والتنظيم وبناء الهوية. وبالتالي تقوم ما بعد الحداثة رمز للتغير الثقافي المعاصر.