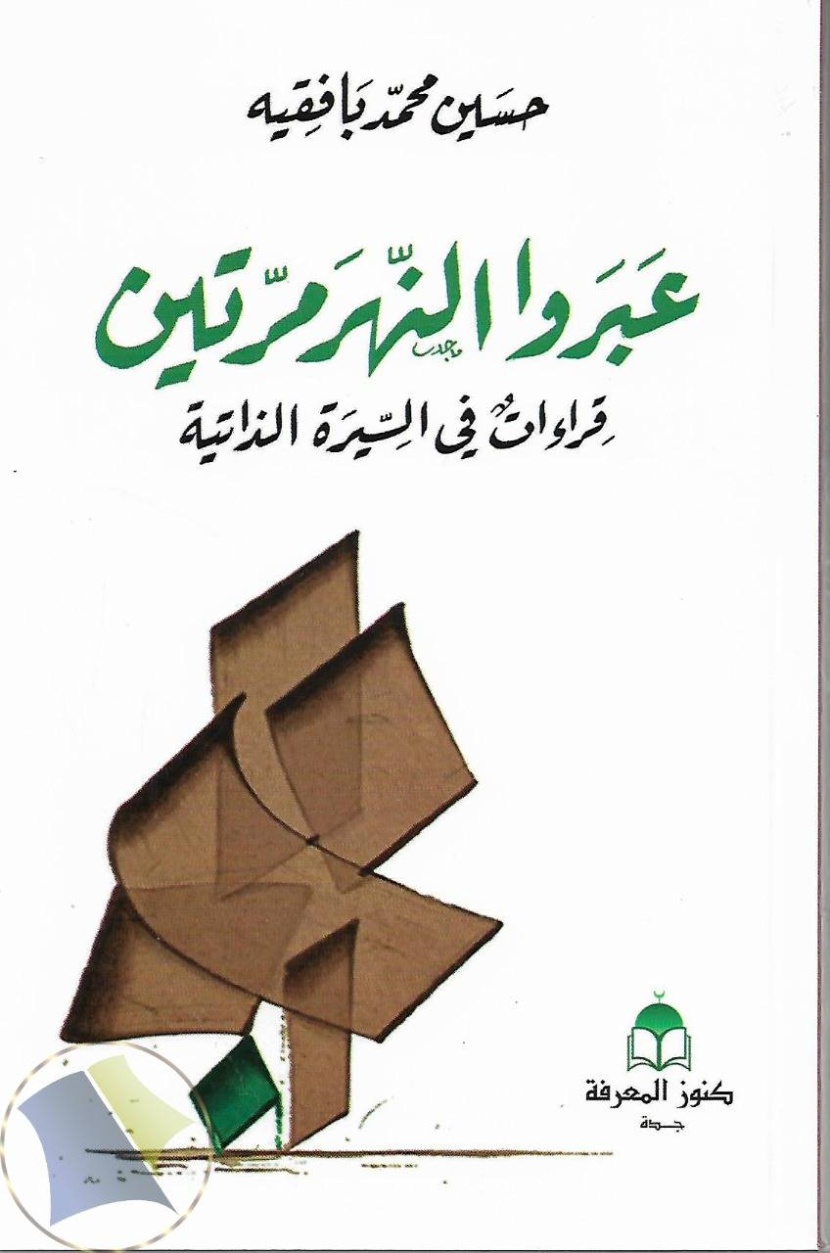"عبروا النهر مرتين" .. الكتب بطبعها خادعة
ينقلب عنوان كتاب وحتى صفحاته الأولى إلى "نشبة" أو مصيدة توقع بقارئ عابر في شراكها، فيصبح أسيرا متن الصفحات دون كلل أو ملل حتى يبلغ نقطة النهاية. كتاب "عبروا النهر مرتين" للمبدع حسين محمد بافقيه من هذا الصنف، فالعنوان الذي يهوي بك سحيقا في الزمن، لأزيد من خمسة قرون قبل الميلاد، وكأنه يحاول نفي إحدى مقولات هيراقليطس، الفيلسوف اليوناني الباكي، "لن تخطو في النهر نفسه مرتين"، قبل أن يستدرك الأمر بتوجيه ذكي، يبعدنا عن سجالات فلاسفة اليونان الأولى حول الكينونة، حملته عبارة "قراءات في السيرة الذاتية".
وشكلت الاقتباسات الثلاثة التي استهلت صفحات المؤلف قبل الديباجة، توضيحا لما يرمي الكاتب إثباته في العنوان، بانتقاء عبارات مختارة بعناية تعزيزا لمتن الكتاب، فانتخب لزكريا إبراهيم فقرة ننتقي منها "أما بعد، فقد قيل لأحدهم يوما: «ها هو ذا كتاب جيد»، فكان جوابه: «إذن، فسيكون أمامي يوم آخر لأعيش! »". ونختار من فقرة إحسان عباس "إن الأشخاص الذين يصلوننا بأنفسهم وتجاربهم هم الذين ينيرون أمامنا الماضي والمستقبل"، ولدى ميخائيل نعيمه نقرأ: "إنني، مهما يكن شأني اليوم أو غدا في دنيا الفكر والقلم، ما برحت واحدا من الناس، تنعكس حياتي في حياتهم، وحياتهم في حياتي. وما قيمة ما كتبته
وسأكتبه إلا في التجاوب بيني وبين الذين يقرؤونني من الناس".
استهلال بسط حسين محمد بافقيه القول دفاعا عنه في ديباجة بعنوان "حب قديم" أوضح فيه أصول المصطلح، واهتمامه المبكر بما كتب في أحوال النفس، وتعزز العناية بفن السيرة الذاتية، وتجذر تعلق الرجل بمتونه، عقب حصوله على كتب لا تزال في قائمة روائع ما وضعت العرب في هذا الفن. فأنشأ يقول في ارتباط دواعي التأليف بمنزلة أدب السيرة عنده، "فوراء هذه الفصول التي كتبتها رغبة ذاتية مخلصة في أن أعرض موضوعا أحببته وعشت في تجارب أصحابه مدة من الزمن".
وأمعن الكاتب في شد وثاق قارئه، بإفراد ثماني صفحات جوابا عن سؤال "لماذا نقرأ السير الذاتية؟"، فالكتب بطبعها خادعة، وتزداد الغواية أكثر متى تعلق الأمر بمصنفات السيرة الذاتية، بامتزاج سحر العناوين مع جمالية الأغلفة وثقل أسماء المؤلفين. قبل أن يستدرك وبلسان الشاعر الإنجليزي صامويل تايلر كولريدج: "أي حياة مهما كانت تافهة ستكون ممتعة إذا رويت بصدق"، بذلك يكون الصدق شرطا أساسيا في هذا الفن، حتى إن لم يكن كاتبها ذا شأن في حياة الناس، ففي أنفس القراء ميل طبيعي للوقوف على حيوات الآخرين، بمجرد توافر الحد الأدنى من الصدق، فهو بمنزلة تعاقد ضمني بين الكاتب والقراء.
شرط عصي على التحقق، فالإنسان يعيش ليروي، كما يقول جابرييل جارسيا ماركيز، ولكنه يعيش كذلك لينسى، طوعا أو كرها، فالأدب بمختلف أصنافه ثمرة ملاحقة بين الذاكرة والنسيان. فالكتابة أيا تكن، تبقى بحسب بافقيه، مقابلة بين التذكر والنسيان، والكاتب حين يثبت جملة فإنه يمحو أخرى. والسيرة الذاتية، هي تلك الحياة التي تتأرجح بين الذاكرة والنسيان، بين ذاكرة موشومة لا تنسى شيئا، وأخرى مثقوبة لا تبقي شيئا. إن غسق الذاكرة، في تشبيه رائع للكاتب، "محاولة لتذكر وجوه البيدق والخيول قبل أن يسقط الملك".
أتقن بافقيه إغواء الذاكرة ببراعة، فكلما تقدم القارئ في صفحات الكتاب تتضخم الأسئلة حد الحيرة، بعدما تحولت قراءة السير إلى سجال فكري حول أسس وثوابت فن السيرة، أوشك على التحول إلى نقاش فلسفي، بمقاربات عربية وغربية، فكتب الرجل مستفهما في صيغة إشكالية: "هل الحياة إلا تلك الطبقات التي تكونها الذاكرة؟"، وذهب حد الاستعانة بإرث زعيم المدرسة الرومانسية في فرنسا، بداية القرن 19، الفيكونت دوشاتوبريان، حين قال: "سيختزل وجودنا إلى لحظة متعاقبة من حاضر يتلاشى أبدا، ولم يكون لنا ماض أبدا. أي مخلوقات مسكينة نحن، فحياتنا من الخواء بحيث إنها ليست أكثر من انعكاس لذاكرتنا".
يبقى النبش في الذاكرة بحثا عن الذكريات، أو ممارسة "لذة التذكر" من أجل الكتابة، محاولة عيش أخرى، كما جاء على لسان الأديب ميخائيل نعيمة: "إنني إذ أنكب على هذا الكتاب فأستعيد ذكريات ما كان من أمري في هذه الدنيا، سأكون كمن يعيش عمره مرتين". قول تكتنفه الكثير من النسبية، فاستدعاء الذكريات من أجل الكتابة يقتضي من صاحبها، كما ثبت في "ديبلوماسي من طيبة" للمؤلف نزار عبيد مدني "إن أراد أن يكون أديبا فنانا، أن يثبت شيئا ويمحو شيئا آخر، وبين المحو والإثبات، وبين التذكر والنسيان تستوي السيرة الذاتية بين يدي قارئها".
فضلا عن اختلاف السير باختلاف تجارب ومواقع أصحابها، فالوظائف والمواقع والسياقات تتحكم، بدرجات متفاوتة، في وضع حدود لما يجوز قوله، لذلك لم يتردد مبدعون في إذابة الذات "الأنا" وسط الجماعة "النحن"، فكتبوا سيرا للحديث عن جيل بأكمله، مثلما هو الحال مثلا مع عبد الواحد الحميد في سيرته "أعوام الجوف.. ذكريات جيل"، حيث تقرأ سيرة إنسان من خلال سيرة جيل وسيرة مكان. وافتقر آخرون إلى روح الإقدام والثقة بأنفسهم، فتحدثوا في مواضع من سيرهم بلسان غيرهم، وإن كانت أحاديثهم عن خاصة ذواتهم.
وكتب كثيرون تصفية لحساباتهم مع التاريخ أو بحثا عن الإنصاف من ظلم ألم بهم أو جحود لحقهم، وهذا ما يظهر في "مسيرتي مع الحياة" لمحمد بن أحمد الرشيد، وزير التربية والتعليم الأسبق، حين كتب يقول: "إلى الحريصين على الوقوف على الحقيقة المجردة تحت ضوء الشمس لا يغطيها تزوير ولا يجملها تزيين. وإلى من حجبت عنهم الرؤية: عواطف جامحة، وملابسات معقدة، وأحكام مسبقة، وأخطاء في التفكير والتقدير.. الشهود عما قليل يتساقطون، والذاكرة تخون".
أيا تكن دواعي كتابة السيرة، كما بين بافقيه من خلال قائمة من السير التي نثرها بعرض وتقريض جميلين بين يدي قرائه في الكتاب، يبقى المؤكد أن فعل الكتابة أشبه باستدعاء سحائب الذكرى، كما وصف الكاتب سيرة عبدالرحمن السدحان، التي قد تمطر وقد تحبس ماءها، وحتى إن أمطر وجادت بمائها، فكاتب السيرة حينها يشبه من يقف أمام مرآة، فهو مضطر لإصلاح شأنه وتعديله هيئته، حتى يظهر بهندام أنيق.