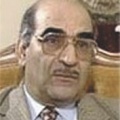الجوهر الفرد كأساس لرؤية للعالم ...
إذا كانت فكرة "الجوهر الفرد" أو الجزء الذي لا يتجزأ، قد أثيرت أول الأمر مع أبي الهذيل العلاف، كما رأينا في المقال السابق، لإثبات إحاطة علم الله بكل شيء وقدرته على إبطال الاجتماع والاتصال في الأجسام حتى تصير أجزاء لا تتجزأ، فإنها سرعان ما وظفت، وعلى نطاق واسع، في القضية الأساسية في علم الكلام، قضية إثبات "حدوث العالم". لقد اتخذ منها المتكلمون مقدمتهم الضرورية لإثبات وجود الله ووحدانيته ومخالفته لكل المخلوقات. وطريقتهم في الاستدلال على ذلك كما يلي: يقولون إن القسمة العقلية تقتضي أن العالم، إما أن يكون قديما وإما أن يكون محدثا، ولما كان العالم عبارة عن أجسام، وكانت الأجسام مؤلفة من أجزاء فإن الحكم على العالم بالقدم أو بالحدوث يتوقف على تحديد طبيعة تلك الأجزاء. فإن كانت لا تتجزأ إلى ما لا نهاية له فالعالم سيكون قديما، أما إن كانت تقف فيها التجزئة عند حد معين فمعنى ذلك أنه محدث. وهم يبرهنون على أنها بالفعل لا يمكن أن تتجزأ إلى ما لا نهاية، وأنه لابد أن تقف فيها التجزئة عند جزء لا يتجزأ! يقولون إن المشاهدة تدلنا على أن بعض الأجسام أكبر من بعض، فلو كانت تقبل القسمة إلى ما لا نهاية له لكان عدد أجزاء الجسم الصغير، كالنملة، مساويا لعدد أجزاء الجسم الكبير، كالفيل، ولكان الجسمان بالتالي (النملة والفيل) متساويين في المقدار، وهذا خلاف المشاهد. وإذن فلا بد أن تكون الأجسام مؤلفة من عدد محدود من الأجزاء حتى يمكن أن يكون بعضها أكبر من بعض كما هي في الواقع.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلما كانت الأجسام تعتريها "أعراض" ضرورة، إذ لا بد في كل جسم من لون وطعم وشكل وحركة وسكون.. إلخ، وهي أعراض تعرض له، فإن الجواهر الفردة التي تتألف منها الأجسام لا بد أن تعتريها نفس الأعراض، وإلا كيف يمكن أن يكون الجسم على حالة (باردا مثلا) وتكون أجزاؤه على غير تلك الحالة (غير باردة)؟ وإذن فالأجسام، وبالتالي العالم كله، جواهر وأعراض. وبما أن الأعراض تتغير باستمرار، فالمتحرك يسكن والساكن يتحرك والألوان تتغير وتتجدد.. إلخ، فهي حادثة. وبما أن الجواهر لا تنفك من الأعراض، إذ لا يتصور وجود جوهر دون أعراض، فهي (أي الجواهر) لا تسبقها في الوجود، وبالتالي فهي حادثة مثلها، وإذن فالأجسام، وهي مركبة منها، حادثة مثلها. وبما أن العالم كله مؤلف من أجسام فهو حادث كذلك.
وإذا تقرر هذا، سهل في نظرهم، إثبات وجود الله. ونقطة الانطلاق عندهم في ذلك هي قولهم "إن الحادث لا بد له من محدث". وهذه قضية لا يبرهنون عليها وإنما يستندون في إقرارها إلى المشاهدة التي تدل على "أن الكتابة لا بد لها من كاتب، ولا بد للصورة من مصور، وللبناء من بان"؛ كما يستندون في ذلك إلى تحليل معنى الحدوث: فالحادث عندهم هو، بالتعريف، "ما يجوز وجوده وعدمه، ويجوز أن يكون على غير ما هو عليه". وبما أن الأشياء موجودة، وعلى وجه مخصوص، فإنه لا بد أن تكون هناك إرادة أرادت وجودها بدل عدمها، وأرادتها موجودةً على الصورة التي هي عليها. وبالتالي فالله، بوصفه المحدِث للعالم المريد له على ما هو عليه، موجود.
تلك هي الاعتبارات الدينية الكلامية التي قادت المتكلمين إلى القول بفكرة الجوهر الفرد، وهي اعتبارات ترجع إلى ميدان "جليل الكلام" (= علم الله، قدرته، إحداثه للعالم...). غير أن المتكلمين لم يقفوا بهذه الفكرة عند هذا المستوى، بل راحوا، في إطار مجادلاتهم في "دقيق الكلام"، يناقشون مختلف جوانبها ويتتبعون كل ما يلزم عنها حتى أصبحت أساسا لنظرية في "الوجود": في المكان والزمان والحركة والفعل... وبالتالي أساسا لرؤية معينة للعالم، رؤية بيانية ذات خصائص مميزة، سيكون علينا الآن الشروع في وصفها وتحليلها.
لنبدأ بشرح تصورهم للمكان:
لا نجد في الحقل الدلالي للغة العربية قبل ازدهار علم الكلام معنى أو معاني محددة لـ "المكان"، بل كل ما هناك تصورات لا تتجاوز مستوى الحدس الحسي الابتدائي الذي يربط المكان بالمتمكن فيه. وهكذا فـ "المكان"، كما يعرفه صاحب "لسان العرب"، هو "موضع لكينونة شيء فيه… تقول العرب كن مكانك وقم مكانك واقعد مكانك". فالمكان إذن هو "الموضع". وهذا الأخير" مصدر، من قولك وضعت الشيء من يدي وضعا وموضوعا". أما "وضع الشيء في المكان" فمعناه إثباته فيه. ومثل الموضع "المحل" وهو من "حل" بمعنى: نزل، نقيض الترحال". فالمحل إذن هو الموضع الذي يحل فيه الشيء. وهكذا فالمكان والموضع والمحل كلها بمعنى واحد، وليس فيما جمعه اللغويون عن عرب الجاهلية وصدر الإسلام، ما يدل على أنه كان لديهم حدس للمكان بوصفه إطارا مجردا تنتظم فيه الأشياء يكون كـ"وعاء" لها. بل المكان عندهم هو دوما مكان للشيء، لا ينفك عن المتمكن فيه حتى على صعيد التصور.
وقد احتفظ المتكلمون بهذا التصور للمكان المبني على الحدس المشخص للمكان والمتمكن فيه وأقاموا عليه نظريتهم في الجوهر الفرد، أو الجزء الذي لا يتجزأ، قالوا: الجوهر الفرد هو آخر جزء يمكن أن ينقسم إليه الجسم، وأنه من الصغر والدقة بحيث لا كم له ولا طول ولا عرض ولا عمق، ومع ذلك فهو عندهم ذو "قدر"، غير أنه "ليس لقدره بعض" أي لا يتجزأ، كما أنه ذو "حظ ثابت من المساحة"، ولكن دون أن يكون في "مكان"، محتجين لهذا بالقول إنه لو قلنا إنه في مكان "لكان مكانه جوهرا، ثم يتسلسل القول في مكانه ومكان مكانه". وإنما قال المتكلمون بهذا لأنهم لا يتصورون المكان مستقلا، بل المكان عندهم لا ينفصل عن الشيء المتمكن فيه. وقد اعترض كثير منهم على التصور الفلسفي للمكان الذي يقول: "إن المكان ما أحاط بغيره من جميع جوانبه"، محتجين بأن "أهل اللغة لا يصفون القلنسوة المحيطة بالرأس بأنها مكان الرأس، ولا يصفون القميص المحيط بالإنسان بأنه مكان له".
الجواهر الفردة، إذن، لا يحتويها مكان فأين "تقيم"؟