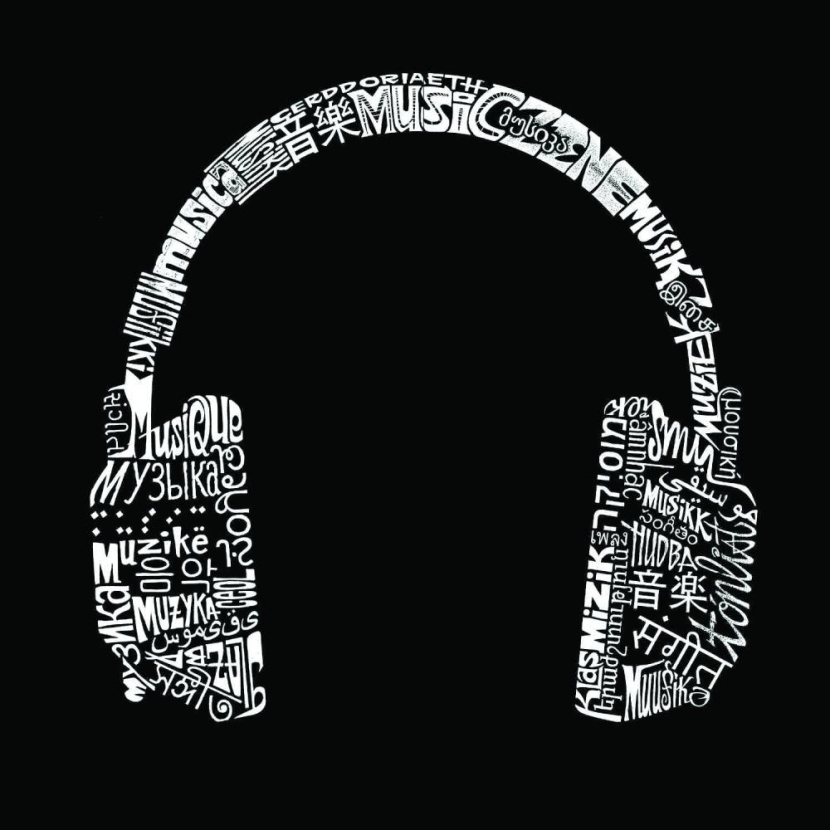الموسيقى .. لغة تخاطب كوني بلا مترجم
يحتفل العالم باليوم العالمي للموسيقى، في 21 يونيو من كل عام منذ 1982، تاريخ دعوة جاك لانج وزير الثقافة الفرنسيين إلى الاحتفال بالمناسبة لأول مرة، فحينها أطلقت وزارته هذه المبادرة تحت شعار "اعزفوا الموسيقى في عيد الموسيقى"، واختار هذا اليوم لتزامنه مع حدث الانقلاب الصيفي، حيث نهاية الربيع وبداية الصيف.
نجحت فرنسا في تصدير هذه المناسبة لتصبح عيدا عالميا، وارتقى كثير من الدول التي تعد الموسيقى جزءا أساسيا فيها، كإيطاليا واليونان وكولومبيا ولوكسومبورج بهذه المناسبة إلى مرتبة العيد الوطني فيها، حيث تحرص على الاحتفاء باليوم العالمي لـ"غذاء الروح" وأحد أرقى الفنون وأنبلها، بشكل رسمي على جميع مستويات الدولة، بهدف التواصل بين الثقافات، واكتشاف مختلف الحضارات عبر لغة عالمية يفهمها الجميع.
لغويا، تعرف الموسيقى من ناحية المفهوم بكونها فنا مؤلفا من الأصوات والسكوت عبر فترة زمنية، وهي من الفنون التي تهتم بتأليف وإيقاع وتوزيع الألحان وطريقة الغناء والطرب، كما تعد علما يدرس أصول ومبادئ النغم من حيث التوافق أو الاختلاف. تعود أصول كلمة الموسيقى إلى اليونان، حيث كانت تطلق على الفنون بوجه عام، قبل أن تنحصر في وقت لاحق في لغة الألحان فقط. وعرفت لفظة موسيقى بأنها "فن الألحان وهي صناعة يبحث فيها عن تنظيم الأنغام والعلاقات فيما بينها وعن الإيقاعات وأوزانها".
تاريخيا، يصعب تحديد البدايات الأولى للموسيقى، فثيودور فيني يعد في كتابه "تاريخ الموسيقى العالمية" أن جميع الحضارات دخلت العصر التاريخي مزودة بآلات موسيقية، وكان لبعضها ذخيرة من الأساطير التي تفسر اختراعها، وأن وجود الآلات الموسيقية يشهد بأن انفصال الخط اللحني والإيقاعي عن الكلمات أمر كان معروفا منذ عهد بعيد، غير أن التساؤل سيظل قائما حول طريقة وتوقيت الاكتشافات التي أسست مفاهيم الإيقاع واللحن، كوحدات تعبيرية متباينة، وأدت إلى اختراع الآلات الموسيقية، التي كانت أصلا مجرد أدوات مساعدة للألحان والإيقاعات التي يصنعها الإنسان، ثم أصبحت بعد ذلك بديلا عنها.
كانت الموسيقى رديفة الوجود البشري على الأرض، ففي البدء قلد الإنسان أصوات الطبيعة والطيور والحيوانات، ثم مزج بينها ليبدع في التأليف والصناعة الموسيقية، بحسب الأغراض والوظائف، فكانت لدى شعوب وسيلة للتعبير والتواصل، وعند حضارات أخرى طقسا دينيا تعبديا، وعدها آخرون أسلوبا للترفيه والمرح والترويح.. بذلك تبقى الموسيقى فنا اجتماعيا، تختلف أغراضه من مجتمع إلى آخر، لكنها تخضع في المقابل للقوانين، فيحكمها الانتظام والتناسق في ترتيب موادها.
أضيف الغناء والرقص إلى الإيقاع الموسيقي، واستخدم الإنسان التصفيق بالأيدي والدبك بالأرجل، ثم جاءت مرحلة قرع الحجارة والأخشاب ببعضها. ندرك من وجود الآلات الموسيقية أصول انفصال اللحن عن الكلمات، لكن السؤال يظل قائما بشأن طريقة وتوقيت الاكتشافات التي أسست مفاهيم الإيقاع واللحن، كوحدات تعبيرية متباينة، وأدت إلى اختراع الآلات الموسيقية، التي كانت أصلا مجرد أدوات مساعدة للألحان والإيقاعات التي يصنعها الإنسان، ثم أصبحت بعد ذلك بديلا عنها.
اكتشف الإنسان وقع وتأثير الموسيقى الساحر، بعد عملية مزج الألحان والإيقاع بالكلمات والحركات الجسمية على الإنسان، ما جعل الموسيقى لغة تخاطب عالمي لا تحتاج إلى ترجمة. الموسيقى ليست كاللغة بالمعنى المفهوم، أي أنها لا تحمل أي دلالات سيميائية، على الرغم من الاستجابة لها كأداة تواصل. ليس بعدها صوتا فقط، فما أكثر أصوات الضرب والاحتكاك التي نسمعها طوال اليوم، دون أن يلحقنا الأثر ذاته، وهذا سر الموسيقى الذي جعل فيلسوفا متشائما مثل شوبنهاور يعترف بأن الموسيقى "أكثر اختراقا لذواتنا من كل الفنون الأخرى، لأن كل تلك الفنون تخاطب الظلال فقط، بينما تخاطب الموسيقى الجوهر".
يحضر سؤال الموسيقى بقوة لدى الفلاسفة، فيلسوف ألمانيا الأكبر فريدريك نيتشه، في كتابه "مولد التراجيديا"، يعد "الموسيقى هي شرط ترانسندالي سابق للغة"، وقبله ذهب فيلسوف أفلاطون إلى أن "الموسيقى هي قانون أخلاقي" فلها القدرة على دعم العنصر الفاضل في الشخصية أو زيادة ميلها إلى الرذائل، تبعا لنوع الألحان والإيقاع والمقام المستخدم فيها. تعدد آراء ومواقف وتعقيبات محبي الحكمة في الموسيقى وعنها، التي حاول المؤلف جوليوس بورتنوى تتبعها ورصدها في تسعة فصول "اليونان، العصور الوسطى، عصر الباروك، التنوير.." تضمنها كتابه الشيق "الفيلسوف وفن الموسيقى".
اهتم العرب عبر التاريخ بالموسيقى والألحان، وتأثروا بالموسيقى الشرقية "الفارسية والمصرية والتركية" التي تشترك معها في الاتصال الوثيق بجنس الإيقاع الموزون. وكان قدماء العرب أول من استنبط الأجناس القوية في ترتيبات النغم، ولهم عشرات من المصنفات والفصول في الكتب عن أدبيات وأسس وقواعد الموسيقى. بعيدا عن التقعيد تولى المستشرق هنري جورج فارمر التأريخ بشكل تحقيبي للموسيقى العربية، في كتابه المهم "تاريخ الموسيقى العربية"، فقد تتبع مسار وتطور هذه الموسيقى في فصول كتابه عبر مختلف العصور "الجاهلي، الإسلام، الراشدي، الأموي، والعباسي"، فبحث في كل عصر على حدة نظرة الأمراء "الموقف" للموسيقى والفنون، ثم تطور الموسيقى، مستعرضا الآلات الموسيقية والتجديدات والألوان الغنائية والكتب المؤلفة والمواقف الشائعة.
تؤكد آراء أن النهضة الموسيقية في أوروبا الوسيطة كانت بفضل تراكمات العرب التي دخلت أوروبا من جهة الأندلس، وقد بلغ التأثر بها حد اقتباس التسمية، خلال العصور الوسطى يطلق على فناني شعر الغزل "تروبادورز" Trobadors، وهذه الكلمة تشبه إلى حد كبير كلمة "طرب" العربية التي تعني الفرح، تعبيرا عن الطبيعة التي غالبا ما تكون ممتعة لعزف الأغاني. وهناك تكهنات تدعي أن ويليام أكيتاين أول شاعر أوروبي متجول، كتب أربعة أبيات من الشعر الأندلسي في إحدى مخطوطاته.
لن يجد كل من عاشق للموسيقى غرابة في ذلك، فهذا هو السر الدفين فيها، حيث يتذوق الإنسان موسيقى شعوب وحضارات قد يعجز عن تحديد موقعها على الخريطة، لكنه حتما قادر على فك رموز رسالتهم الموسيقية والتواصل الروحي معهم بسهولة ويسر، لذا قيل - وعن حق – إن الموسيقى لغة عالمية في متناول الإنسانية قاطبة.