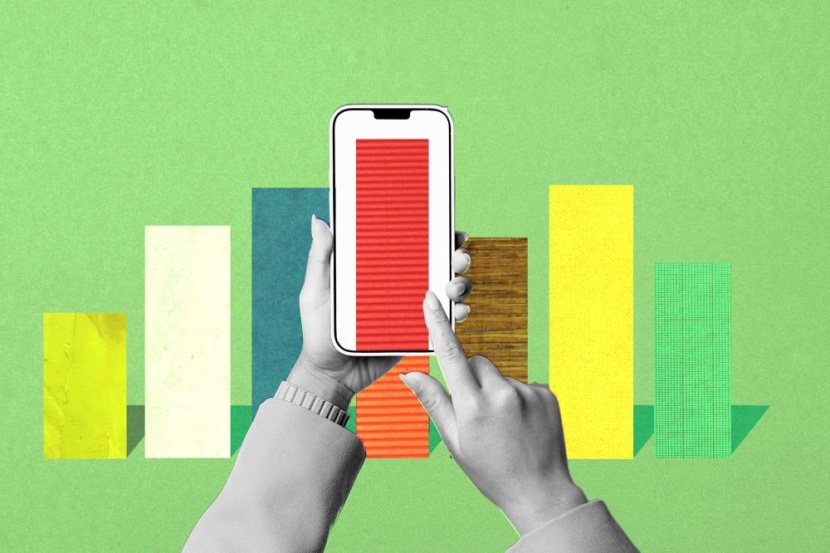لندن .. مدينة تمضي تاركة المملكة المتحدة وراءها
في النسخة الأصلية من فيلم "ألفي" الذي صدر عام 1966، نرى مايكل كين يتمشى في الشارع الخلفي من كينجز كروس. المكان عبارة عن خرابة عمرانية: لندن التي لا تتحرك بنشاط. في عام 1987، توفي 31 شخصا في حريق في محطة القطار المتهالكة المجاورة. السلالم الخشبية التي تئن فوق الشحم القابل للاشتعال والقمامة، سمحت للنار بالانتشار بسرعة كبيرة. بعد ذلك بعقد من الزمن، أخبر توني بلير أحد الصحافيين عن العار الذي شعر به عندما قاد سيارته مع أولاده عبر كينجز كروس، وهو مكان كان في 1997 لا يزال مرادفاً للتشرد والدعارة.
الآن ستكون ماهرا في الإقناع، إذا استطعتَ إقناع أي لندني ولد في ذلك العام أن هذا الجزء من المدينة كان مكاناً بائساً معروفاً على مستوى العالم. محطة سانت بانكراس مُضاءة من الداخل إلى الخارج، ومحطة المسافرين الدولية تعجّ بركاب يوروستار المتوجهين إلى باريس. الطريق الذي مشاه ألفي هو الآن مكان عام أنيق تتخلله شقق حديثة ومطاعم عصرية. "جوجل"، وصحيفة "الجارديان"، وكلية سانت مارتينز سنترال، حلت محل الأحياء الفقيرة. وفقاً لشركة آرجان، التي تتولى إعادة تطوير المنطقة، نصف مشاريعها الكبيرة لم تأت بعد. كينجز كروس، مثل كناري وارف قبلها، أصبحت رمزاً لظهور لندن ربما كأنها مدينة العالم - وليس مجرد مدينة عالمية.
لكنها أيضاً رمز للتباعد بين لندن وبقية بريطانيا. من كينجز كروس، أو سانت بانكراس، بإمكانك اللحاق بقطار متوجه إلى زوايا يائسة من الشمال وإلى ميدلاند، تلك المناطق التي فشلت في رفع نفسها من حالة التراجع في أهميتها الصناعية ـ ليس لتقصير في الجهود. لندن، في المقابل وبشكل يُثير الغضب، بإمكانها تحويل حتى زواياها الأكثر اتساماً بالسخرية والفوضى والرذيلة إلى أماكن مرغوبة للعيش والعمل فيها. بين عامي 2010 و2013 كانت هناك رافعات تعمل في العاصمة أكثر مما هي في بقية بريطانيا مجتمعة.
الأرقام الاقتصادية، وليس مشهد ناطحات السحاب فقط، تُشير إلى مملكة غير متحدة. لقد بلغ إنتاج لندن من حيث القيمة المُضافة الإجمالية للفرد 175 في المائة من المتوسط البريطاني عام 2012. سوق العقارات في ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية معاً تساوي تقريباً نفس القيمة الإجمالية لأغلى عشرة أحياء في لندن. وأسوأ أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية لم تكُن كافية لإيقاف نمو لندن بنسبة 12.5 في المائة بين عامي 2007 و2011 ـ أكثر من ضعف متوسط المملكة المتحدة. بقية البلاد لا تستطيع مواكبة كينجز كروس، ناهيك عن المناطق الغنية مثل مايفير وماريلبون، التي تبدو كأنها جنيف وأبو ظبي أكثر مما هي أرض بريطانية.
هناك كثير من الطلب على لندن بحيث إن شركات التطوير العقاري تستطيع انتقاء واختيار من ستسمح له بدخول بقعتها الجديدة. حول ساحة جراناري في الطرف الشمالي من مشروع كينجز كروس، لا توجد سلسلة مطاعم. لقد فضّلت شركة أرجان خلق "نسيج" من خلال منح الشركات المستقلة موطئ قدم. توني ترافرس، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد، يُشير إلى أن عددا قليلا من المناطق في البلاد يستطيع أن يمارس التمييز بهذا الشكل.
انفصال ثقافي
وهذا هو مجرد البُعد المادي من الشقاق الوطني. من الناحية الثقافية، أيضاً، انفصلت لندن عن بلدها المُضيف منذ مدة طويلة. فهي ليست المدينة الأكثر تنوعاً إلى حد كبير في بريطانيا فقط، لكن ربما الأكثر تنوعاً في العالم. ومن المعقول، مع أن المؤرخين غير واضحين بهذا الشأن، أنها المدينة العالمية الأكثر تنوعاً في التاريخ. أكثر من ثُلث سكانها مولودون في بلدان أجنبية. متوسط من هم من المملكة المتحدة 13 في المائة. البريطانيون البيض أقلية في العاصمة، حيث توجد أكثر من 300 لغة منطوقة، و50 مجموعة غير أصيلة، مع عدد سكان يزيد على 50 ألف لكل مجموعة.
تعتبر لندن عولمة مُتجسّدة. أحياءها، وقطاعها المالي، ومطاعمها، حتى نواديها لكرة القدم أعيدَ تشكيلها من قِبل الغرباء. لكنها تقع في بلد يبدو أحياناً أنه يبتعد عن القوى العالمية والاضطرابات التي تجلبها. حزب الاستقلال البريطاني، الحركة التي تريد أن تجعل العالم يبتعد، هي الموضة الانتخابية الرائجة في الوقت الحاضر. الحزب يحصل على أصوات من كافة أنحاء إنجلترا على أساس منصته المناهضة للهجرة، حتى إنه فاز في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في أيار (مايو). مع ذلك، في لندن، أداؤه أقل إثارة للإعجاب بكثير. العاصمة تميل نحو حزب العمال، مع أنه أكثر ليبرالية من اليسار المتشدد، لهذا السبب فاز المُحافظ العالمي بوريس جونسون باثنتين من الانتخابات البلدية.
الحكومة تحاول تضييق الفجوة بين لندن وبقية بريطانيا. إلا أن هذا ما تفعله الحكومات دائماً. في عقود ما بعد الحرب، الصناعات الثقيلة التي أبقت المدن الشمالية مستمرة، كانت مدعومة أو تم تأميمها. في الثمانينيات، مايكل هازلتاين، الديجولي بين المحافظين، استخدم منصبه وزيرا للبيئة لتأسيس "مجالس تنمية بلدية" لإحياء ليفربول وشمال شرق إنجلترا. في العقد التالي، جرب حزب العمال الجديد "وكالات التنمية الإقليمية"، وهو مجرد تنويع شكلي في الموضوع نفسه. الآن جورج أوزبورن، وزير المالية من حزب المحافظين، يأمل "في إعادة توازان" بريطانيا مع "قوة محركة شمالية" من خلال تحويل الأموال والصلاحيات إلى أماكن مثل مانشستر. المدينة متحمّسة لكن التوقعات ارتفعت في السابق أيضا.
عندما يتحدث السياسيون عن إعادة التوازن، فهم في الواقع يقصدون إحداث التوازن. الأمر ليس كما لو أن النظام الطبيعي للأشياء في بريطانيا كان في الأصل انتشاراً متساوياً تقريباً للثروة والسلطة في جميع المناطق. تفوّق لندن متأصل تاريخياً. خلال قرون من الزمن كانت أكبر بعدة مرات من المدينة التي تليها في المساحة. كل ما تغيّر هو هوية المدينة الثانية. المدن من أمثال لنكولن ونورويتش وبريستول وبرمنجهام ظلت تتنافس على مركز الوصيف خلال الأعوام الـ 500 الماضية أو أكثر.
ومع الرهانات الذكية على أن مدنا أخرى ستفلح في تحقيق المساواة، ينبغي أن تستعد بريطانيا لاضطراب سياسي في الوقت الذي تصبح فيه عاصمتها عالماً قائماً بذاته، مع مصالح ومطالب متميّزة. مدينة التداول المفتوح هذه تنزعج بالفعل من القيود على الهجرة المفروضة على مستوى بريطانيا. فهي معرضة للخسارة من جولة جديدة من الضرائب على العقارات باهظة الثمن أكثر من أي مكان آخر في المملكة المتحدة. ويُسهم سكانها على نحو غير متناسب في الخزينة الوطنية، الأمر الذي يعني من الناحية العملية أنها تدعم مناطق أخرى.
الحديث عن فقدان لندن صبرها مع كل هذا، وأنها ستصبح مدينة دولة، خيالي. لكن تفويض صلاحيات أكبر لمكتب عمدتها الضعيف (بحسب المعايير الدولية) يبدو أمراً لا مفر منه. في الوقت الحالي، لا يملك جونسون سوى سيطرة معقولة على النقل والإسكان والشرطة. قد يضطر صنّاع السياسة الوطنية أيضاً إلى ابتكار طرق من أجل استثناء العاصمة، مثلا عن طريق استحداث تأشيرة عمل في لندن فقط للمهاجرين.
الغنى والفقر
لكن هناك نوعين من الشقاق في العمل هنا، وليس واحداً فقط. إذا كانت لندن تبتعد عن بريطانيا، فإن أجزاء صغيرة مختلفة من لندن تبتعد أيضاً عن بعضها بعضا. الأنماط الاقتصادية والاجتماعية تختلف على نطاق واسع في كافة أنحاء المدينة. في كينجز كروس، متوسط العمر المتوقع 79 عاماً. وفي نايتسبريدج، على بُعد ثماني محطات فقط من خط بيكاديللي، متوسط العمر المتوقع 91 عاماً. وينخفض إلى 75 عاماً في لويشام، جنوب شرق المدينة.
97 في المائة من السكان في بلدة كامدين يستطيعون الدخول إلى الإنترنت. الرقم يصبح 82 في المائة فقط في باركينج وداجينهام، على الهامش الشرقي من العاصمة. وبعض أفقر الأحياء في المملكة المتحدة توجد في لندن، مثل تاور هامليتس وهاكني. هذا كان صحيحاً في منتصف التسعينيات أيضاً، لذلك 20 عاماً من النمو المذهل جعلت المدينة أكثر ثراءً، لكن ليست أكثر مساواة. وحتى في تلك الأحياء يكمن عدم المساواة بشكل كبير، حيث ينظر شباب الموضة من خلال نظارات أوليفر بيبولز (التي يبلغ سعرها 200 جنيه) ويبحلقون في المهاجرين الذين يشْقون في الحصول على لقمة العيش في الاقتصاد غير الرسمي.
عدم المساواة عمل على تحفيز شيء من رد الفعل ضد لندن الحديثة المعولمة. ويأتي ذلك من اليسار الليبرالي بقدر ما يأتي من المنحازين لحزب الاستقلال البريطاني. هناك حنين للمدينة كما كانت في السبعينيات: غير رائعة، لكن بأسعار معقولة. نوتينج هيل لم تكُن مثالية في ذلك الحين. هامبستيد، الآن قرية أنيقة للأثرياء جداً، كانت موطناً للأكاديميين من الطبقة المتوسطة. والطرف الشرقي كان لا يزال لندنياً. وشراء منزل لم يكُن مهمة تحتاج إلى جهود جبارة كما هو بالنسبة لسكان لندن الشباب اليوم. بعضهم يرى علامات استفهام أخلاقية بشأن الأموال الأجنبية التي تتدفق الآن إلى المدينة، من الأغنياء المتنفذين الروس ومن الشرق الأوسط وأماكن أخرى.
المظالم تكون أحياناً ذات طابع جمالي أكثر مما هو معنوي: بالنسبة لكل لندني يتلذذ بمشهد الأفق الذي يمتلئ بناطحات السحاب بسرعة من هامبستيد هيث أو جرين بارك، هناك آخرون يشتمون الزجاج والصُلب الذي بلا روح، والمجمعات السكنية الجديدة التي لا تنسجم مع الأنماط المعمارية المحلية.
مع ذلك، من الصعب دفع هذا الجانب من الحجة بعيداً بدون تحوّل الحنين إلى تاريخ سيئ وصورة مثالية من القذارة. خراب دوكلاندز لم يكُن ساحراً، على الأقل بالنسبة للناس الذين كانوا يعيشون هناك. الإهمال الذي سمح للسلالم الخشبية بأن تبقى عاملة في مركز النقل الرئيسي حتى وقت متأخر يصل إلى عام 1987 لم يكُن دليلاً على "الشخصية" أيضاً. إذا كانت لندن أرخص في الماضي، فذلك بسبب التراجع وهجرة السكان. انخفض عدد السكان في المدينة إلى 6.7 مليون نسمة بحلول الثمانينيات. وحقيقة أنها تجاوزت في الآونة الأخيرة ذروتها في كل وقت، البالغة 8.6 مليون نسمة، هي دليل على النجاح، حتى إن كانت تُخفي بعض التفاوت المؤلم في الثروات. الناس يختارون القدوم إلى لندن وإنجاب الأطفال هنا.
عدم المساواة يتجذر في المدن الكبيرة، فهي تُغري الناس المستميتين للحصول على فرصة وتؤوي أولئك الذين نجحوا بالفعل. إذا أردنا الواقع، فإن لندن كانت بارعة في تسخير ثرواتها للخير الأوسع. في عهد كين ليفينجستون، سلف جونسون، كانت اتفاقيات ما يُسمى القطاع 106 تُلزِم شركات التطوير العقاري ببناء مساكن بأسعار معقولة، ومرافق بيئية وما شابه ذلك، مقابل الحصول على تصاريح التخطيط. إنها إعادة توزيع بوسائل أخرى. النمو جلب معه البنية التحتية. شبكة المواصلات في لندن تعتبر من بين أوسع الشبكات في العالم، وتستمر في الوصول إلى مجالات جديدة مثل كروس ريل، قطار الأنفاق السريع الذي يعتبر أكبر مشروع إنشائي في أوروبا. لندن هي مدينة الثروات الضخمة المبهرجة والفقر المدقع، لكنها أيضا مدينة المتاحف المجانية والمتنزهات العامة ذات المستويات العالمية.
مع ذلك لا يمكننا تجاهل رد الفعل المزدوج ضد لندن – من بلد تخلَّف عنها، ومن الرومانسيين داخل أسوار المدينة. ليس هناك شيء واحد يستطيع أن يقتل هيمنة لندن باعتبارها المركز النشط للعولمة، لكن التراكم التدريجي للقرارات الاستراتيجية السيئة (أو عدم اتخاذ القرارات) يمكن أن يؤذي هذه الهيمنة مع الزمن. العامل الأجنبي الذي لا يُسمح له بدخول لندن يستطيع أن يأخذ مهاراته إلى نيويورك أو سنغافورة. إذا لم يُسمح لمطار هيثرو بالتوسع، فإن المدن التي من قبيل أمستردام وفرانكفورت هي في وضع جيد يؤهلها لتكون مركز الطيران الأوروبي. وإذا فُرِضت ضرائب أعلى وقوانين تنظيمية أقوى، فإن هذا يمكن أن يثبط المستثمرين الذين يتجولون في العالم، عن وضع أموالهم الفائضة في لندن.
استيقظت لندن من رقادها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بما لديها من صفوف ناطحات السحاب والأحياء النشطة، ومن خلال الانفتاح على العالم. وإمكانية بقائها مفتوحة على هذا النحو – أو إذا سمحت لها القوى السياسية في أماكن أخرى في البلد أن تظل كذلك – فهذا واحد من الأسئلة الأساسية في الانتخابات العامة في أيار (مايو) المقبل، وهو سؤال لا بد أن يرجو الليبراليون بالمعنى القديم أن يكون جوابه بالإيجاب. لندن ليست مجرد خرسانة وفولاذ، لكنها تجسيد لفكرة، هي العولمة.