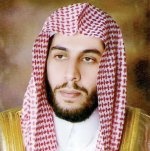المملكة واكبت الانتقال إلى العالم الافتراضي ومكافحة الجرائم المعلوماتية بسن الأنظمة الحديثة وتقرير العقوبات
المملكة واكبت الانتقال إلى العالم الافتراضي ومكافحة الجرائم المعلوماتية بسن الأنظمة الحديثة وتقرير العقوبات
تطورت استخدامات التقنية في كافة أشكال الحياة، خصوصا بعد أن بدأ استخدامها في المملكة مع مطلع عام 1999، وانتشار استخدام الحاسب الآلي في المنزل والمكتب، واتصال الأجهزة بعضها مع بعض عبر الشبكات الداخلية للمنشآت والشبكات المحلية والدولية من خلال الشبكة العنكبوتية، وتناقل البيانات والمعلومات خلالها. ومع وجود هذا العالم الافتراضي انتقلت إليه الجرائم التي كانت فيما مضى لا يمكن تطبيقها إلا على أرض الواقع لتتم عبر تلك الشبكات على ساحات العالم الافتراضي، سواء خلال عالم الإنترنت أو من خلال الاتصالات اللاسلكية المختلفة أو عبر تناقل البيانات البنكية خلال شبكات الصرف الآلي وخلافها، مما تطلب تطوير الأنظمة والقوانين لتواكب ما استجد على عالم الجريمة من طرق تحتم تطوير واستحداث طرق الكشف عنها ومتابعتها وتثبيتها وتوفير الأدلة القاطعة وسلاح الجريمة، وفي هذا الشأن التقت "الاقتصادية" الدكتور سليمان بن محمد الشدي، القاضي بديوان المظالم، والحاصل على الدكتوراه في طرق حماية التجارة الإلكترونية، ودراسة مقارنة من المعهد العالي للقضاء قسم الأنظمة، ليطلعنا على التطور في القضاء في المملكة العربية السعودية ليواكب ما استجد في عالم الجريمة التي انتقلت إلى العالم الإلكتروني، وإطلاعنا على ما تم تطويره من قوانين لكبح وتطبيق العقوبات على المجرمين الإلكترونيين، وما يتطلبه الأمر من تسنين قوانين وتعاون بين دول العالم لمطاردة المجرمين الدوليين، وكان الحوار على النحو التالي:
* ما الأحكام والتشريعات التي تضمنتها الأنظمة في المملكة، وما الجوانب التي شملتها في الجريمة الإلكترونية؟
بداية أشكر جريدة "الاقتصادية" على هذا الحوار، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. قبل الإجابة عن هذا السؤال، يحسن أن أوضح مفهوم الجريمة المعلوماتية، مشيراً إلى أن مصطلح الجريمة المعلوماتية من المصطلحات الحديثة، لذا تجد اختلافاً كبيراً وملموساً في تحديد مفهومه، وذلك ناتج عن حداثة هذا المصطلح وعدم استقرار الرؤية القانونية له، إلا أنه يمكن تحديد مفهوم الجريمة المعلوماتية بأنها (كل فعلٍ أو امتناع عمدي تكون فيه تقنية المعلومات هدفاً للاعتداء أو وسيلة لتنفيذه). أما بالنسبة للوضع التشريعي في المملكة فهو يعتمد على منهجين فريدين، وهو ما جاء النص عليهما في النظام الأساسي للحكم. فالمنهج الأول هو: كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام، وأما الثاني فهو: ما يصدره ولي الأمر من أنظمة.
فإذا نظرنا إلى الجريمة المعلوماتية وفق المنهج الأول (كتاب الله وسنة رسوله ) من جهة مدى استيعاب هذا المنهج للصور الحديثة من الاعتداءات والجرائم، نجد أن قواعد الشريعة الإسلامية جاءت بحماية الأفراد والمجتمعات من جميع أشكال الاعتداء، بصرف النظر عن شكله الذي تم به، وأداته التي استخدمها، والزمن الذي تم فيه. وذلك من خلال تقرير قاعدة عامة لحماية الضروريات الخمس، تكون هذه القاعدة (حفظ الضروريات) سياجاً عاماً لحق الإنسان في حفظ نفسه ودينه وماله وعقله وعرضه. فالأحكام على المستجدات توضع بما يراعي حفظ الضروريات، وهي: حفظ الدين والنفس (والنسل والعرض) والعقل والمال، والحفظ لها يكون من جانب الوجود وذلك بما يقيم أركان هذه الضروريات ويثبتها ويحميها من كل ما يعرض وجودها واكتماله للضرر، وحفظها من جانب العدم، وذلك بما يدرأ عنها الخلل والواقع والمتوقع.وبالتالي فأي تصرف أو ممارسة أياً كان شكلها وصورتها ووسيلتها ووقتها، من شأنها أن تنال من هذه الضروريات أو الاعتداء عليها فإنها تعد ممارسة منهي عنها لمخالفتها أصلاً شرعياً، وهذا من ميزات التشريع الإسلامي. فإذا تطلب الإجراء القانوني عند متابعة أو محاكمة أصحاب الاعتداءات الإلكترونية وجود نص يحرم الفعل ويجرمه، فإن هذا الأصل الشرعي العام يحقق ذلك، بالاتفاق مع القاعدة القانونية (لا جريمة إلا بنص).
أما إذا نظرنا إلى الجريمة المعلوماتية وفق نصوص النظام السعودي، فإن المملكة ومنذ دخول شبكات الاتصال المعلوماتية وشبكات الإنترنت اهتمت بتنظيمها ووضع ضوابط لاستخدامها، كما اهتمت بموضوع الاعتداءات، سواء تلك التي تصدر منها باعتبارها وسيلة للاعتداء، أو التي تقع عليها باعتبارها هدفاً ومحلاً للاعتداء، وذلك من خلال قواعد نقل المعلومات السريع الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 163 وتاريخ 24/10/1417هـ. وبالتالي فإن نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ليسا المبادرة الأولى للمنظم السعودي في التعامل مع شبكات الاتصال، بل إن النواة التشريعية الأولى للمنظم السعودي في مجال شبكة الاتصال والربط المعلوماتي هي قواعد نقل المعلومات السريع فيما تضمنته من مواد وفقرات حددت ضوابط العمل على الشبكة، كما حددت الالتزامات الملقاة على المستخدم، وجرمت بعض صور الاستخدام غير المشروع للشبكة، فهذه القواعد تعد وثيقة تنظيمية مبكرة في تأصيل العمل الإلكتروني، وأيضاً في مكافحة بعض صور الاعتداءات الإلكترونية، مما يجدر الإشادة بها كدليل على جاهزية ومبادرة النظام السعودي لمواجهة المستجدات التقنية الحديثة التي يفرضها التقدم العلمي، بعدها سايرت الأنظمة التطور التقني الهائل في مجال شبكات الاتصال والمعلومات. كما واكبت نمو الاستثمار المعلوماتي الكبير في هذا المجال، واتجاه المستثمرين إلى تقديم رؤوس الأموال في مجال تقنية المعلومات والاتصال، فصدر نظام التعاملات الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم م/18وتاريخ 8/3/1428هـ، الذي تناول الأحكام الموضوعية والشكلية للتعامل الإلكتروني من حيث إرساء قواعد موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بواسطة سجلات إلكترونية يعول عليها، وإضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها وتيسير استخدامها على المستوى المحلي والدولي، للاستفادة منها في جميع المجالات، وإزالة العوائق أمام استخدامها، ومنع إساءة الاستخدام لها أو الاحتيال فيها. كما تناول النظام المركز الوطني للتصديق الرقمي بتحديد اختصاصاته وأحكام تقديم خدمات التصديق وواجبات ومسؤوليات مقدم الخدمة والمخالفات في ذلك. كما صدر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كجانب حماية للتعاملات الإلكترونية، بهدف تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب وحماية الاقتصاد والأمن.
#2#
أما بخصوص الجوانب التي تشملها الجريمة الإلكترونية فهي تشمل كل الجرائم والمخالفات التي تتم في الوضع العادي التقليدي ويمكن الشروع فيها وارتكابها من خلال الوسائط الإلكترونية، باستثناء الشروع المادي والارتكاب الفعلي لجرائم الاعتداء البدني والإتلاف المادي، إلا بوصفه محرضاً أو مخططاً أو معاوناً لا منفذاً. كما تشمل تلك الجرائم والمخالفات الحديثة التي لم تعرف إلا بظهور تقنية الاتصالات وشبكة المعلومات، كالدخول غير المشروع لمواقع الشبكة أو الإضرار بالشبكة ونحوها من جرائم مستحدثة، إذاً فالجرائم الإلكترونية تشمل:
- الاعتداء على الدين والعقيدة ببث أو نشر أو إعداد أو توزيع أو تخزين مواد أو وسائط متعددة معادية للدين، أو تنال من قدسيته، أو التشكيك في أحكامه القطعية، أو تتعارض مع العقيدة أو تنال منها. وقد أكدت على ذلك الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- الاعتداء على النفس بالتحريض على القتل أو التهوين من شأن الاعتداء على النفس المعصومة، أو التخطيط أو الإرشاد بشكل يهدف لارتكاب جريمة الاعتداء على النفس.
- الاعتداء على المال أياً كان شكل هذا المال، أو وصفه، طالما أنه محترماً ومتقوماً شرعاً ونظاماً وعرفاً، وأياً كان شكل الاعتداء من ذلك.
- التحريض أياً كان دافعه على إتلاف مقدرات البشر الإنشائية من مبان وجسور ومنشآت حكومية أو خدمية أو مطارات، والمساهمة في ذلك بالإرشاد والتخطيط أو مجرد التخطيط، فهذا وعلاوة على أنه قد يكون فيه اعتداء على النفس، فإنه اعتداء على المال بإتلاف هذه المقدرات البشرية والإفساد في الأرض.
- الاعتداء على المال الإلكتروني من أموال نقدية أو بيانات ائتمانية أو حسابات بنكية إلكترونية أو كلمات مرور لمعلومات أو حسابات ذات قيمة مالية متقومة بسرقتها أو اختلاسها أو خيانة الأمانة أو نهبها، وبشكل عام الظهور على المال الإلكتروني بمظهر المالك ممن ليس له بمالك، أو بما يتجاوز الصلاحية المأذون بها من قبل المالك , وقد أكدت على ذلك الفقرتان (1و2) من المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- قد يكون الاعتداء على المال في الجرائم الإلكترونية بالعبث والإتلاف بالبيانات الإلكترونية والمواقع وقواعد البيانات للمواقع. وأكدت على ذلك المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- ومن صور الاعتداء على المال العبث به بالطرق المنهي عنها شرعاً، كالميسر ونحوه من الصور التي تعد من قبيل العبث بالمال، وإنفاقه بالطرق غير المشروعة. وقد أكدت ذلك الفقرة الثالثة من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- الاعتداء على العقل: فالعقل البشري هو مناط التكليف، والذي ميّز الله به البشر وكرمهم به وأمرهم بأعماله فيما فيه صلاحهم وخيرهم. إذاً فكل ما يمس سلامة العقل البشر فهو أمر منهي عنه شرعاً، سواء كان ذلك بتغييب هذا العقل عن الوعي والإدراك الكامل عن طريق مواد مخدرة أو مسكرة أو مضعفة، وذلك ببيع هذه المواد أو الترويج لها أو الدعوة لتناولها عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو كان الاعتداء على العقل عن طريق الأفكار والمبادئ التي تتعارض مع فطرة العقل البشري وسلامته في علاقته بربه وبمجتمعه. وأكدت على ذلك الفقرة الأولى والرابعة من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- الاعتداء على العرض والنسل: فقد اعتبرت الأديان سلامة العرض والنسل ضرورة من الضروريات، لما لسلامتها من دور في حماية الأسرة والمحافظة عليها باعتبارها نواة المجتمع ولبنته الأساسية، ومنع إشاعة الفاحشة والمنكر بين المجتمعات، بالتالي فإن أي عمل، حتى وإن تم إلكترونياً، يهدف إلى النيل سلامة أعراض الناس بالقذف أو التشهير أو السب والشتم أو إلحاق الضرر بهم أو التعرض لحياتهم الخاصة بالتجسس أو التعرض لحياتهم الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، فإنه يعد جريمة إلكترونية. وقد أكدت الفقرة الرابعة والخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على ذلك.
- أما الاعتداء على النسل وكيان الأسرة فيتمثل إلكترونيا بإنشاء ونشر المواد والبيانات التي تدعو إلى الرذيلة والمتعلقة بالشبكات الإباحية والاتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل معه، مما يعد ذلك معارضة حقيقية يهدد كيان الأسر وسلامتها ويشيع الفاحشة بين المجتمعات. وقد أكدت على منع ذلك الفقرة الثانية والثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- كما أن الجريمة الإلكترونية تشمل أمراً مهماً يتعلق بأمن المجتمع والدولة وسلامتهما، وهي الجرائم الأمنية المنظمة التي تعمل وفق تخطيط وقيادة، وذلك فيما يتعلق بتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة المواد التخريبية. كما تشمل هذه الجريمة الدخول إلى المواقع أو الأنظمة المعلوماتية للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، فهذه تعد من جرائم الإفساد في الأرض، والتي أولت قررت الشريعة الإسلامية تجريمها وتقرير الجزاء الرادع لمن يرتكبها ، كما نصت المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على هذا النوع من الجرائم.
- ومن صور الجريمة الإلكترونية، ما يعرف بالجريمة الإلكترونية الحديثة، والتي لم تظهر إلا بظهور التقنية الحديثة، كالاعتداء على المواقع الإلكترونية بالدخول غير المشروع، سواء نتج عنه تدمير هذه المواقع أو شغلها أو إتلاف ما تحويه من قواعد بيانات أو معلومات، بل مجرد الدخول غير المشروع عدته بعض الأنظمة الدولية مخالفة توجب الجزاء. وقد يكون الاعتداء على الشبكة المعلوماتية بإيقافها أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها. هذه الجريمة الحديثة الظهور من حيث كيفيتها هي في حقيقتها تنطوي على تخريب وإتلاف لحق الغير من أفراد ومؤسسات خاصة أو عامة، مما يمكن معه للقاضي استنتاج حكمها إذا لم ينص عليه في النظام، من خلال القواعد الشرعية التي أحاطت المال العام والخاص بالحماية، تأسيساً على الضابط الشرعي المهم، وهو أن حماية المال وجوداً وعدماً من الضروريات الشرعية التي قررت الشريعة حمايته عند النظر في أي نازلة أو واقعة تتطلب حكم الشرع.
كما أن الاعتداء خصوصية الفرد عند معالجة بياناته إلكترونياً وذلك بتغيير الغرض الذي من أجله جمعت البيانات أو قيام غير المختص بالاطلاع عليها يعد صورة حديثة في الاعتداء الإلكتروني تطلب تدخل المنظم بوضع ما يحمي خصوصية الأفراد عند معالجة بياناتهم .
- ومن صور المخالفات الإلكترونية، الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف. فمع ظهور الشبكات الإلكترونية، والتي أدت إلى: وضع العالم في نطاق إلكتروني متقارب، وأظهرت خدمة البحث في الشبكة بشكل فعال وميسر، مما سهل من الحصول على المعلومة، وإمكانية الحفظ والنسخ والتخزين للمعلومات المعروضة على الشبكة ، وأيضاً إمكانية عرض المعلومات على الشبكة من غير قيد أو تحفظ أو وجود إجراءات معينة من خلالها يتم التأكد من صفة الناشر.
فقد أدى ذلك إلى ظهور اختراقات هائلة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، سواء كانت حقوق أدبية من نشر معلومات دون استئذان أصحابها، أو عدم نسبتها لهم، أو حقوق مالية من نشر معلومات أو وسائط متعددة ذات قيمة مالية من غير المصرح لهم بذلك، مهدرين بذلك حقوق المنتج والمالك والمؤلف وما يبذلانه من جهد ومال في إخراج هذه المعلومة أو هذا المنتج، مما يتوجب معه إعادة النظر في هذا الموضوع وإيجاد صياغة جديدة تعيد توازن الموضوع بين ملاك المنتجات والمؤلفات الفكرية وبين عموم المستخدمين والمستفيدين بما يضمن ملكية هذه المنتجات الأدبية والمؤلفات لأصحابها واستفادتهم منها، ويضمن استفادة المستخدم من غير إضرار به. وفي هذا المجال فقد صدرت اتفاقية دولية جديدة عرفت بـ(معاهدة الإنترنت)، انضمت إليها بعض دول، وهي تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت (حق المؤلف وحق المنتج).
* هل طوعت هذه التشريعات بطريقة يمكنها متابعة التطورات التي قد تستجد مستقبلا في هذا العالم الإلكتروني المتجدد؟
فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية (كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام)، فإن الشريعة صالحة لكل زمان متجاوبة مع وسائل العصر ومستجداته، فهي شريعة رب العالمين أكملها وأتمها، فلا تمانع الشريعة من التجاوب مع معطيات العصر ومستجداته بما يحقق الصلاح والتكامل للمجتمعات، وبما يكفل جلب ما فيها من خير وتقدم ومنع ما فيها من شر وأذية، وذلك متى ما بذل طالب العلم جهده وفق القواعد الأصولية المرعية في هذا الجانب.
أما ما يتعلق بالجانب الآخر من أنظمة ولوائح، فإنه من الأمور المهمة.