طوال سبعة عقود ونصف من عمر هذه الجائزة السنوية؛ منذ انطلاقتها الأولى في عام 1901، لم يستطع أي حدث حجبها؛ غير بداية ونهاية الحرب العالمية الأولى (1914 و1918)، وأحداث الحرب العالمية الثانية (1940 حتى 1943). إضافة إلى حجبها سنة 1935، لأسباب لم يكشف عنها مطلقا.
يجد الحجب علّته في عدم تحقُق النصاب المطلوب قانونا، لانعقاد لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، بعد إضافة أربعة أعضاء جُدد هم: المؤرخ بيتر إنجلند، والشاعر كيل إسبمارك، والروائي كلاس أوستيرغرين، والشاعرة كاترين فروستين إلى ستة أعضاء آخرين، سبق لهم أن قدموا استقالتهم من عضوية اللجنة، على خلفية فضيحة التحرش التي عصفت بالأكاديمية.
مع توقف عضوين من لجنة التحكيم عن العمل مع الأكاديمية منذ سنوات، أصبح عدد الحكام الفعليين فيها عشرة أعضاء فقط، وبحسب القانون الداخلي للأكاديمية لابد من بلوغ النصاب المحدد في الثلثين؛ أي 12 عضوا من أصل 18، من أجل الإقرار بشرعية انعقاد اللجنة.
شكّل نزيف الاستقالات صدمة للجميع، فالقواعد الجاري وفقها العمل تقضي ببقاء أعضاء اللجنة، في مناصبهم مدى الحياة. ولا يحِق لأحدهم الاستقالة البتّة، مهما كانت الظروف. لكن المؤرخة الأدبية سارة دانيوس؛ أول امرأة تمكنت منتصف عام 2015 من شغل منصب سكرتير اللجنة منذ تأسيس الجائزة، تخطّت تلك القواعد حين صرحت بشكل مقتضب، أنها "فقدت الثقة بالأكاديميّة".
تاريخيا، ليست هذه أول مرة يستقيل فيها أعضاء من الأكاديمية، فقد سبق لثلاثة أعضاء أن قدموا استقالتهم، احتجاجا على عدم إدانة الأكاديمية للفتوى التي أصدرها الخميني سنة 1989، في حق سلمان رشدي؛ بعد نشر روايته "آيات شيطانيّة"، لكن استقالاتهم لم تقبل حينها.
عاد موضوع الاستقالة إلى واجهة النقاش داخل أروقة الأكاديمية سنة 2005، بعد قرار اللجنة منح الجائزة للروائية النمساوية ألفريده يلنك، حيث قرر الأديب والمؤرخ السويدي كنوت أنلوند الاستقالة احتجاجا على هذا التتويج، مبررا موقفه من هذا الاختيار بقوله: «إن لغتها الأدبية بسيطة، ونصوصها كتل كلامية محشوة، لا أثر لبنية فنية فيها، نصوص خالية من الأفكار، لكنها مليئة بالكليشيهات والخلاعة العلنية»، فظل مقعده في لجنة التحكيم شاغرا حتى وفاته عام 2012.
بيد أن الأمر مختلف هذه المرة، فالمسألة مرتبطة بفضيحة أخلاقيّة مدوية، لم تترك أي هامش أمام المستقيلين قصد العدول عن استقالاتهم، والعودة إلى العمل لدى الأكاديمية التي فقدت الشيء الكثير من مصداقيتها.
طالما عبر كثير من المتابعين في العالم عن خيبة أملهم من نتائج جائزة نوبل، فما أكثر المرات التي جاء فيها اسم الفائز أو الفائزة عكس ما ذهبت إليه كل التخمينات والتوقعات. ولم يتردد كُتاب كبار غير ما مرة من انتقاد نتائج اللجنة، بعد مراجعة العمل الذي مُنحت بناء عليه الجائزة.
بمجرد ما تظهر مثل هذه الانتقادات حتى يبدأ اللغط ومعه نقاشات حامية، وينبري تيار جارف من المهتمين للدفاع عن اللجنة والجائزة والفائز، معتبرين أن أفراد لجنة تحكيم الأكاديمية فوق هذه الانتقادات، وأسمى من حسابات ضيقة لا توجد سوى في مخيلة مروجيها.
غير أن هذه الفضيحة المدوية، تسلّحنا بدليل يعزز تلك الانتقادات، بل يثير فينا رغبة جامحة باستعراض أسماء من فازوا بهذا التكريم العالمي، ومراجعة قائمة طويلة من المتوجين بلغت 109 أسماء، لنجد أن بينهم أسماء لمبدعين لا يملكون تاريخا أدبيا يكفي لمنحهم حتى جائزة في ناد ثقافي صغير.
قد تكون هذه الواقعة فرصة أمام الأكاديمية قصد القيام بمراجعة جذرية لقانون الجائزة، وفق ما يتلاءم وتطورات الزمن الراهن. خصوصا أن بعض التعديلات التي أدخلت على وصية نوبل من قبيل إمكانية منح الجائزة لثلاثة أشخاص بدل شخص واحد، أبانت عن فعالتها ونجاعتها.
من أبرز الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة وتقنين، مسألة إعادة رسم الحدود، وتحديد النطاقات التي تغطيها الجائزة، والحرص على فك الارتباط مع الدلالات السياسية التي يتم إضفاؤها على الجائزة من حين لآخر.
وفق ما جاء في الوصية، تسعى الجائزة إلى تكريم الروائيين والشعراء والكتاب المسرحيين، ممن تركوا بصمة نوعية في مجال إبداعهم. إلا أن قائمة الفائزين تضم أسماء خارج هذه الحقول الإبداعية، ففيها المؤرخ الألماني تيودور مومسن (1902)، والسياسي البريطاني ونستون تشرشل (1953)، والموسيقى البريطاني بوب ديلن (2016)، وثلاثة فلاسفة هم: الألماني رودلف أوكن (1908)، والفرنسي هنري بيرجسون (1927)، والبريطاني برتراند راسل (1950).
صحيح أن هذه الجائزة الأعرق والأكثر شهرة في العالم؛ وذات هيبة وجلال كبيرين، يترقبها المهتمون من كل بقاع العالم سنويا، تفتح أبواب العالمية، وتعبد الطريق لصاحبها نحو النجومية في سماء الأدب؛ من خلال تسليط الأضواء على المؤلِف والمؤلَف الفائز وباقي إبداعاته على مدار سنة التتويج؛ وحتى بعدها، فالجائزة بمنزلة اعتراف لنائلها بالتفرد والتميز.
لكل ذلك صار من الضروري مراجعة قانون الجائزة، حتى تحافظ على رمزيتها. ليس فقط بسبب هذه الفضيحة، وإنما تصديا للسيولة والميوعة والتفاهة أو باختصار لـ"غزو البلهاء" بتعبير المفكر الإيطالي أمبرتو إيكو التي يشهدها حقل الأدب، بسبب وسائل التواصل الاجتماعي التي أضحت ملاذا لكل الباحثين عن الشهرة والنجومية بأسرع وقت وأقل مجهود.





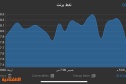


أضف تعليق